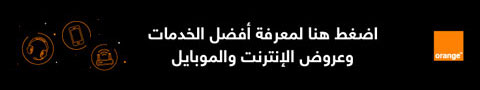ميسر السردية تكتب: الديمقراطية في الفكر العربي والإسلامي بين التنظير وفشل التطبيق

نبأ الأردن -
مع بدايات عصر النهضة في العالمين العربي والإسلامي، أخذ مفهوم الديمقراطية يشق طريقه إلى الفضاء الفكري والسياسي ضمن واقع اتسم بترسخ حكم الفرد وتراجع الحيوية الثقافية. وقد أسهم الاحتكاك بالفكر الغربي، بالإضافة إلى ضغوط الاستعمار وتسلط الداخل، في دفع عدد من المفكرين إلى إعادة التفكير في بنية السلطة السياسية وسبل إصلاحها. إلا أن دخول هذا المفهوم لم يكن خاليا من التوتر، إذ عُد عند بعضهم عنصراً غريباً على البنية الحضارية، بينما رأى فيه آخرون ضرورة لوضع حدّ للاستبداد. وعلى اختلاف اتجاهاتهم، حاول الجميع الاستناد إلى قيم الشورى والعدل في التراث الإسلامي لتأصيل رؤيتهم لمفهوم السلطة وحدودها.
الاستبداد وجذوره الاجتماعية
برز المفكر الفذ عبد الرحمن الكواكبي بوصفه أوضح من قدم تحليلا معمقا لظاهرة الاستبداد. حيث رأى أن الاستبداد لا يقتصر على حكم مطلق يقوم على الغلبة أو الوراثة، بل قد يتمظهر في أنظمة تبدو منتخبة أو دستورية متى غابت عنها الرقابة الفعلية والمحاسبة الحقيقية. فالحكم يبقى مستبدا، في نظره، ما لم تُربط صلاحياته بمسؤوليات واضحة تُلزم المنفذين أمام المشرعين، وتُلزم هؤلاء أمام الأمة التي "يعود إليها الشأن كله". لذلك يعدّ مجرد وجود دستور أو انتخابات أمرا لا يكفي لرفع الاستبداد ما دامت الأمة لا تراقب ولا تحاسب.
الكواكبي يفترض أن مقاومة الاستبداد تقتضي قبل كل شيء تحديد ما سيحل مكانه، فـ"معرفة الغاية شرط طبيعي للإقدام على كل عمل"، غير أن هذه المعرفة لا فائدة منها إذا جُهل الطريق المؤدي إليها، ولا تكفي المعرفة الإجمالية، بل "لا بد من تعيين المطلب والخطة تعيينا واضحا". من هنا، فإن تقرير شكل الحكومة التي ستستبدل بالاستبداد ليس مسألة سهلة تُحسم بفطنة آحاد أو ساعات من التفكير، بل يحتاج إلى رؤية جماعية تُهيئ المجتمع لمرحلة ما بعد الاستبداد. وقد ربط الكواكبي هذا التحليل بفلسفته الأعم التي تقول إن "أصل الداء هو الاستبداد السياسي ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية".
ويتعمق في التحليل إلى بُعد اجتماعي وأخلاقي مهم جدا، وبذلك يكون قد توصل الكواكبي باكرا إلى ما يُعرف بالتطبيع والتشرب وإعادة إنتاج العلاقات الأبوية، حين يرى أن الشعوب لا تُبتلى بالمستبدين اعتباطا، بل لأنهم صورة منها، فإذا سأل سائل: لمَ يبتلي الله عباده بالمستبدين؟ فإن "أبلغ جواب مسكت هو أن الله عادل مطلق لا يظلم أحدا، فلا يولي المستبد إلا على المستبدين". ويذهب إلى أن كل فرد أسير للاستبداد يحمل في داخله استعدادا لممارسته لو تمكن، وأن عبارة "كما تكونوا يولّى عليكم" ليست مجرد حكمة، بل توصيف لآلية دائرية يُنتج فيها المجتمع استبداده ويعيد تكريسه.
هذا الارتباط بين المجتمع والمستبد لفت إليه عدد من الساسة والمفكرين من زوايا مختلفة. فمثلًا وجد ماريو بارغاس يوسا، مرشح الانتخابات البيروفية، وعضو لجنة الإعلام والديمقراطية التي أنشأتها منظمة "مراسلون بلا حدود"، أن "شهوة السلطة السياسية يمكن أن تدمّر عقلا بشريا، وتدمر مبادئ وقيما، وتحوّل البشر إلى وحوش صغيرة"، و أضاف بعد تجربته السياسية: "أن الطغاة ليسوا كوارث طبيعية، بل تتم صناعتهم بمعاونة عدد من البشر، وأحيانا بمعاونة ضحاياهم". أما الفيلسوف الفرنسي إتيان دو لابواسيه، صاحب المقالة الشهيرة "العبودية الطوعية"، فذهب إلى أن الشعوب لا تُستعبد إلا لأنها تستسلم طوعا، مؤكدا أن "الناس يتحولون إلى ما يصنعون بأنفسهم أو ما يدعون الغير أن يصنعه بهم"، وأن الطغاة لا يطمئنون إلى قوتهم إلا إذا جعلوا أتباعهم "رجالًا لا قيمة لهم على الإطلاق". من جانب آخر حذر المؤرخ البريطاني توماس ماكولي، من انتظار الحرية داخل ظل الاستبداد قائلا: "إذا انتظر الناس الحرية إلى أن يكتسبوا الحكمة والصلاح وهم في ظل حكم الاستبداد، فبشرهم أنهم سينتظرون أبدا".
ملاحظات الفيلسوف برتراند راسل ركزت بدورها على المنحى الأخلاقي ، فرأى أنه "تاريخيا، أية مجموعة بشرية توكل إليها السلطة ستسيء استخدامها إلا إذا خشيت فقدانها"، وأن الأنظمة الجامدة تُنبت القسوة في نفوس أصحاب السلطة، ما يدفع بقوى المقاومة في النهاية إلى انفجار عنيف يعكس تراكم الألم
في دفعه عن اتهامه بتأييده للحاكم المستبد العادل،كما أشيع عنه، يقول جمال الدين الأفغاني الأب الروحي للحركات الإصلاحية والوطنية : "أن هذا من قبيل جمع الأضداد، كيف يجتمع الاستبداد والعدل؟! فخير صفات الحكم القوة والعدل، ولا خير في الضعيف العادل، كما أنه لا خير في القوي الظالم."
مطلع القرن الماضي، فجّر الشيخ علي عبد الرازق جدلا عميقا شمل كافة منابر الدين والسياسة بين مؤيد ومعارض لمواقفه، حين أصدر كتابه "الإسلام وأصول الحكم"، حيث رأى أن "لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذُلّوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم".
وفي شأن الحكم أيضًا وشكله ، دعا رائد حركة الإستقلال الجزائري الشيخ عبدالحميد بن باديس إلى التمييز مابين الدين والسلطة والحكومة، رافضا الخلط إلى درجة الاتحاد بين الدولة والدين. ورأى أن السلطة والسلطان يجب أن تكون للكفاءة والحصول عليها عن طريق رضى الأمة وتأييدها. فالأمة صاحبة الحق والسلطة في الولاية والعزل ولا يتولى أحد أمرها إلا برضاها.
وعبر هذه الأصوات، يظهر أن الاستبداد ليس مجرد خلل سياسي، بل ظاهرة تتغذى من بنية المجتمع نفسه ومن استعداد للامتثال والطاعة العمياء. وأن الديمقراطية، من منظور هؤلاء المفكرين، ليست مجرد آليات انتخابية، بل منظومة من القيم التي لا تُسترد إلا بالوعي بمعنى الحرية وبناء ثقافة المشاركة والمسؤولية.
بناءً على ما سلف، تعددت الرؤى بين عدة تيارات فكرية ناقشت جدلية الديمقراطية والاستبداد في العالم العربي والإسلامي، مما أوجد تنوعا وتباينا بين مواقف تلك التيارات:" مع، ضد" أو من اتخذت مكانة وسطية بين حدين.
التيار المؤيد للديمقراطية: ضرورة التحديث والنهضة
يرى خالد محمد خالد في كتابه الديمقراطية أبدا، أن الديمقراطية ضرورة لا تستقيم بها حياة الأمم، فاستمرار السلطة المطلقة يفسد الحكم ويقمع الحرية، إذ تحيط بالحاكم حاشية تُقصي الشعب والدستور وتوهمه بأنه الأقدر على الرأي، فيستسهل قمع المعارضة وإسكات أصواتها. ويؤكد أن الدين الحق يقف مع حق الإنسان في حكم نفسه، وأن تكون الحكومات ثمرة اختيار حر، وأن تعود منافع السلطة للشعب كله لا لفئة ضيقة. وكان خالد من أبرز المدافعين عن ضرورة تطبيق التجربة الديمقراطية في العالم العربي بوصفها شرطا للنهضة وحمايةً للكرامة الإنسانية.
وتطور مفهوم الديمقراطية مع تحرر الإنسان من الإقطاع والسلطات المقدسة، لكنه ظل قائمًا على جوهر ثابت: حكم الشعب نفسه سياسيا واقتصاديا، فلا ديمقراطية بلا عدالة اجتماعية وتكافؤ فرص يمنع تمركز الثروة واضطراب المجتمع. وللتأكيد على ضرورة التشريع العادل، عرض خالد مراحل تطوره عبر التاريخ منذ حمورابي مرورا بأثينا وروما، حيث ترسخ مبدأ المساواة أمام القانون واعتبار الكفاءة أساس المسؤولية.
وخلص إلى أن الديمقراطية لا تكتمل إلا بتلازم ديمقراطية الحكم والتشريع والمجتمع، ثم أن التفاوت بين الجنسين وتباين الفرص من أخطر ما يهددها، ولا خلاص للأمة إلا بحكم شعبي واعٍ يصون كرامتها السياسية والاقتصادية.
الديمقراطية ضرورة عصرية للمواطنة
المفكر محمد عابد الجابري في كتابه "الخطاب العربي المعاصر" يقول: الديمقراطية ليست موضوعا للتاريخ، بل هي قبل ذلك وبعده ضرورة من ضرورات عصرنا، أي أنها مقوم ضروري لإنسان العصر الحالي، الإنسان الذي لم يعد مجرد فرد في رعية، بل مواطن يتحدد كيانه بجملة من الحقوق الديمقراطية، والتي في مقدمتها الحق في اختيار الحاكمين ومراقبتهم وعزلهم، فضلا عن حق الحرية والتعبير والاجتماع وإنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات، والحق في التعليم والعمل والمساواة مع تكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية."
إذن، فالمسألة الديمقراطية يجب أن تنطلق لا من إمكانية ممارستها في مجتمع ما، بل من ضرورة إرساء أسسها وتحديد آلياتها والعمل بها بوصفها الإطار الضروري لتمكين أفراد المجتمع من ممارسة حقوق المواطنة، وتمكين الحاكمين من الشرعية الحقيقية التي تبرر حكمهم.
وفي معرض رده على سؤال يطرحه، فحواه: لماذا الديمقراطية؟! يجيب: "إن طرح هذا السؤال يجب أن يستهدف أبعاد العملية الديمقراطية والنتائج المترتبة على تطبيقها وممارستها، لا مجرد صياغة تعريف لها؛ ذلك أنه قد يُتوهم أن الهدف من الديمقراطية يتلخص في تعريفها، وهو حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، أو في أضعف الأحوال: الحكم بإرادة الشعب. ويحدث ذلك كله باسم الديمقراطية تحت شعار الحكم بإرادة الشعب، فتكون النتيجة الكفر بها، ومن ثم صد الناس عنها وطرحهم لشعارات بديلة."
ويضيف الجابري: "عندما نطالب بالديمقراطية، فإننا نطالب بإحداث انقلاب تاريخي في شتى الحقول الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذا ما يتطلب نفسا طويلا وعملا متواصلا. فالديمقراطية في مجتمعاتنا ليست بالقضية الهينة، بل هي مخاض عسير وميلاد جديد، ذلك أن وضع الدولة العربية قد تميز ماضيا وحاضرا بنفي الشريك عن الحاكم، في حين أن الديمقراطية في جوهرها ليست شيئا غير المشاركة الحقيقية في الحكم."
وفي ذات الوقت، يقر الجابري أن الديمقراطية ما زالت تحتاج إلى تأسيس داخل الوعي العربي المعاصر بحيث تتحول من قضية تحيط بها شكوك إلى قناعة لا تتزعزع، كقناعة العقل بالضروريات البديهية.
الديمقراطية كترجمة معاصرة للشورى
يطرح المفكر فهمي هويدي رؤية ثاقبة للعلاقة بين الإسلام والديمقراطية، مؤكدا أنها علاقة تكامل وليست تناقضا. ففي كتابه "الإسلام والديمقراطية" يرى أن الديمقراطية تمثل الترجمة المعاصرة لمبدأ الشورى في الإسلام، وهي أفضل ما توصل إليه العقل البشري لإدارة المجتمع سياسيا.
يؤكد هويدي أن الجمع بين الإسلام والديمقراطية أصبح ضرورة حتمية، قائلا: "بغير الإسلام تزهق روح الأمة، وبغير الديمقراطية يحبط عملها". ثم أن هذه المصالحة من "المعلوم بالضرورة"، وإذا لم تكن ممكنة فيجب "اختراعها" بأي شكل كان.
ويلفت هويدي إلى أن معارضة بعض المسلمين للديمقراطية تنبع من ارتباطها في الذاكرة الجمعية بالمشروع الغربي الاستعماري، وليس من جوهرها القائم على الحرية والتعددية ومشاركة الشعب. ويستشهد برأي الشيخ محمد الغزالي الذي دافع عن الديمقراطية كتنظيم بشري يحمي من الاستبداد ويضمن كرامة الإنسان.
ويخلص إلى أن الإسلام سبق الديمقراطية في تقرير مبادئ الحكم العادل، لكنه ترك التفصيلات والآليات للاجتهاد وفق متطلبات كل عصر، مما يجعل الديمقراطية الضمان الأمثل لتجسيد هذه المبادئ في الواقع المعاصر.
التيار التوفيقي: قبول الآليات ورفض الفلسفة
الديمقراطية كمنتج ثقافي وأخلاقي
من وجهة نظر المفكر مالك بن نبي، التي تضمنتها بعض مؤلفاته، ومن بينها "القضايا الكبرى"، دخل مفهوم الديمقراطية العالم الإسلامي نتيجة التفاعل مع الحضارة الغربية، والإشكالية الأساسية في التعاطي مع هذا المفهوم تكمن في محاولة تقييمه والحكم عليه من زاوية دينية بحتة.
وبناءً على ما سبق، يرى أن المقارنة المبسطة بين الإسلام والديمقراطية تظهر تناقضا ظاهريا، فالديمقراطية تعني سلطة الإنسان، بينما الإسلام يقوم على التسليم لسلطة الله. وهنا يدعو إلى تجاوز هذا التعريف المبسط والنظر إلى الديمقراطية في إطارها العام من خلال ثلاثة وجوه أساسية:
· الديمقراطية كشعور نحو الذات (الأنا).
· الديمقراطية كشعور نحو الآخرين.
· الديمقراطية كشروط سياسية لتنمية هذا الشعور.
إذن: فتحقيق الديمقراطية كواقع سياسي يتطلب توفر شروطها في الشخصية والعادات والتقاليد؛ فهي ليست نظاما طبيعيًا بل نتاج ثقافة معينة وتقدير جديد لقيمة الإنسان. ذلك الإنسان الديمقراطي، حسب وصفه، هو "الحد الإيجابي" بين نافيتين: نافية العبودية (الخضوع المطلق) ونافية الاستعباد (الاستبداد بالآخرين).
أما فيما يخص المقارنة مع الإسلام، فلا يتوانى عن تأكيده أن الإسلام يتفوق على النموذج الديمقراطي الغربي لأنه يمنح الإنسان تكريما إلهيا يضفي عليه قداسة ترفع قيمته فوق كل القيم المدنية. فالإسلام يجمع بين الديمقراطية السياسية والاجتماعية من خلال مبادئه التي تحققت فعليًا في واقع المسلمين، ويشير في هذا السياق إلى أن المسار الديمقراطي الإسلامي توقف مع انتقال السلطة إلى معاوية بن أبي سفيان، الذي مثل بداية تقهقر الروح الديمقراطي الإسلامي.
وتخلص زبدة آراءه إلى أن تأسيس الديمقراطية الحقيقية يحتاج إلى مشروع تثقيفي شامل يشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والسياسية للأمة بأكملها.
الحاكمية الإلهية مقابل الحاكمية الشعبية
شكّل مفهوم "الحاكمية الإلهية"—الذي يُعد أبو الأعلى المودودي من أبرز منظّريه وحجر الزاوية في هذا الفكر. ينطلق المودودي من أن الله هو مالك الكون والحاكم الحق له، وبالتالي فإن أي حكم بغير شريعته باطل. ويستدل على ذلك بأن الإسلام لا يقبل من المسلم أن يعلن إيمانه بالله ثم يحكم في شؤون حياته بقانون غير شرعه، معتبرا أن اتباع القانون الإلهي في الحياة الشخصية والجماعية هو حقيقة الإسلام.
وفيما يتعلق بموقفه من الديمقراطية وضرورتها في المجتمع ونظام الحكم الإسلامي الحديث، يوضح أنه لا يعارض مبادئها الأساسية كالمساوة وتكافؤ الفرص وحرية التعبير. إلا أنه يفرق جوهريًا بين النظامين: فالديمقراطية الغربية تقوم على "الحاكمية الشعبية" المطلقة، حيث الشعب هو مصدر السلطة. أما في نموذجه الإسلامي فتقوم على "الحاكمية الإلهية"، حيث يسلّم الشعب بسيادة الله العليا، وتُمارس السلطة في إطار شرعه عبر آليات الشورى وانتخاب الحاكم ومحاسبته.
وبهذا يُميز المودودي بين قبول الآليات الديمقراطية كوسيلة ورفض الفلسفة القائمة على السيادة المطلقة للشعب، مؤكدا أن السيادة العليا هي لله وحده.
التيار الرافض: الإسلام نظام متكامل لا يقاس بالنظم البشرية
مثّل سيد قطب رأس الحربة في الفريق الرافض للديمقراطية، إذ ربط بينها كمفهوم وممارسة وبين الاشتراكية والإسلام، معتبرا أن الإسلام نظام إلهي متفرد لا يقاس بأنظمة بشرية تحمل النقص والهوى. ويرى أن محاولة الربط تعبير عن شعور بالهزيمة أمام الغرب، بينما الإسلام يقدم حلا متكاملا لمشكلات الإنسان دون تقليد أو محاكاة لأي نظام بشري آخر. ثم يؤكد أن جوهر الاختلاف بين الإسلام وسائر النظم هو أن الحاكمية لله وحده؛ فهو وحده يشرّع، بينما الأنظمة البشرية تمنح الإنسان حق التشريع لنفسه، وهما قاعدتان متناقضتان لا يلتقيان. وعندما تتحقق الحاكمية الإلهية تتأسس الحرية الحقيقية والكرامة المطلقة للإنسان، إذ لا حرية ولا كرامة في مجتمع يُشرّع فيه بعض البشر ويطيع الآخرون.
وعلى مبدأ "نقطة وسطر جديد"، يجزم قطب أن الحاكم في الإسلام لا يصل إلى منصبه إلا باختيار الأمة الحر، ولا تبقى له طاعة إلا بتنفيذه شريعة الله، فالسلطة ليست دينية ذاتية بل مستمدة من الالتزام الإلهي، وإذا ترك الشريعة سقطت طاعته. والشورى أصل حياة الأمة وطريقتها متروكة للظروف والاجتهاد. وهذا النظام يكفل تحقيق العدل والطمأنينة بين الراعي والرعية بالرضا والطاعة النابعة من الضمير لا بالقسر أو الخوف، ويؤسس سلاما اجتماعيا راسخا.
النقد البنيوي: الديمقراطية ليست مفتاحا سحريا
في كتابه "هرطقات الديمقراطية والعلمانية والحداثة" يطرح جورج طرابيشي إشكالية الديمقراطية في العالم العربي بتساؤل جوهري: هل هي "مفتاح سحري" لحل المشكلات، أم "تاج" يكلل التطور العضوي الطبيعي للمجتمع؟ ويؤكد أن النظرة الإيديولوجية الخلاصية التي تعتبر الديمقراطية شرطا مسبقا مطلقا لكل شيء هي نظرة قاصرة وتتناقض مع طبيعتها كسيرورة تاريخية. فالديمقراطية ليست دواءً شاملاً لكل الأدواء، بل قد تحمل في طياتها أمراضًا جديدة إذا ما طُبقت بشكل ميكانيكي واستزرعت في تربة مجتمعية غير مهيأة.
يشير طرابيشي إلى أن الإشكال الأساس يكمن في غياب الحامل الاجتماعي الطبيعي للديمقراطية، الطبقة البرجوازية"ما فوق الوسطى"التي غُيبت في العالم العربي بعد الاستقلال بسبب سلسلة الانقلابات العسكرية التي قضت على براعم الديمقراطية الناشئة. في ذات الوقت، ينتقد النزعة الشعبوية السائدة في الفكر الديمقراطي العربي التي تُشيطن الدولة وتمثل المجتمع، معتبرًا أن هذه النزعة تحمل في طياتها جرثومة شمولية جديدة.
من جهة أخرى، يؤشر طرابيشي إلى أن المعضلة ليست مقصورة على الأنظمة السياسية فقط، بل تمتد إلى بنية المجتمعات العربية نفسها، حيث تنخرط الفئوية والطائفية والقبائلية في تشويه مبدأ التمثيل الديمقراطي. فالديمقراطية الحقة لا تبدأ من صندوق الاقتراع، بل من "صندوق الرأس"؛ بمعنى آخر: من ثقافة وقيم المجتمع. فالمجتمع الذي يريد الديمقراطية في السياسة ولا يريدها في الفكر هو مجتمع يقتلها في مهدها ويحفر قبر انعتاقه بيده.
الديمقراطية موقف وجودي ومعرفي
المفكر حسن حنفي، الذي يُعد أحد رواد المنهج التوفيقي، يعتقد في نتاجه الفكري وفي كتابه "الدين والثورة" أن الديمقراطية تتعدى مفهومها الشكلي كمجرد حكم للأغلبية، لتصبح موقفا وجوديا ومعرفيا. فهي قبل كل شيء "اعتراف باحتمال خطأ الذات" وإيمان بإمكانية التعلم من الآخر، وسعي جماعي نحو حقيقة مستقلة لا تحتكرها جهة واحدة. وهذا المبدأ يقود إلى الاعتراف بشرعية وجود "الآخر" بجانب "الأنا"، ليصبح الحوار بينهما جسرا ومصدرا للحياة والتجديد، وليس مجرد تبادل جاف للرأي دون تلاقح يؤدي في النهاية إلى إثمار.
هنا يحاول حنفي، كما دأب في مشروعه الفكري، قراءة التراث وتأويله ليجزم بأن العالم العربي يعاني من أزمة حرية وديمقراطية شكلت العقبة الأساسية أمام تحديثه وتنويره. وهذه ليست أزمة طارئة بل نتاج تراكم تاريخي طويل تجذرت بذوره منذ انحسار العصر الذهبي للإسلام. وفي تشخيصه هذا يرصد جذرين رئيسيين: جذر تراثي، يتمثل في المناهج والأبنية الفكرية الموروثة من العلوم كافة، الدينية النقلية والعقلية، تلك التي شكلت قوالبنا الذهنية، وجذر واقعي تمثل في النظم الاجتماعية التي أبعدت الجماهير عن المشاركة الفاعلة وعمقت الفجوة الطبقية بين فئات المجتمع.
هنا لا يرمي حنفي كرته ويدير ظهره لها، بل يقدم خطته ليهز الشباك، فيقول: لكي تنقل المجتمعات العربية من حالة الجمود إلى دائرة الاجتهاد يجب عليها مواجهة خمس آليات متجذرة تشكل عوائق بنيوية في وجدانها: وهي "سلطوية التصور" التي تفرض رؤية واحدة للحقيقة، و"حرفية التفسير" التي تقيد النص وتجمده، و"تكفير المعارضة" الذي يحظر تعدد الآراء، و"تبرير المعطيات" الذي يقبل الواقع بسلبية، وأخيرًا "هدم العقل" الذي يحبط القدرة على النقد والابتكار.
والمخرج الحقيقي يكمن في العودة إلى "العصر الليبرالي" الأول في صدر الإسلام، ولا يقصد بالمعنى السلفي، إنما العصر الذي كان قائمًا على الدفاع عن الحريات الفردية والعامة والتعددية والعدل والمساواة. فالديمقراطية برأيه ليست نظاما غربيا مستوردا، بل هي "روح الشريعة وأساس نظامها". فالغاية هي استعادة هذا المبدأ الإنساني العالمي، ولا مشاحة في الألفاظ إن كان المعنى يونانيا أو إسلاميًا، المهم أن يكون أصيلا وجوهرا مشتركا للإنسانية.
لماذا أخفقت الديمقراطية في الواقع العربي؟
شكلت آراء المفكرين العرب والمسلمين حول مفهوم الديمقراطية وتطبيقها على مدى زمني طويل لوحة فكرية غنية تتراوح بين المخالفة المطلقة والموافقة المطلقة والموافقة المشروطة. فبينما ذهب البعض إلى رفضها جملة وتفصيلا معتبرين الشريعة الإسلامية بديلا شاملا وكافيا يغني عنها، رأى فيها فريق آخر توأمةً مع جوهر الإسلام في قضايا تداول السلطة وطبيعة علاقة الحاكم بالمحكومين وإرساء قيم العدل والمساواة. في حين توقف فريق ثالث عند منزلة وسطى فقبل الديمقراطية كآلية ومنهج لكن بشروط ضابطة تستند إلى ثوابت العقيدة، مؤكدين على أن الإسلام ليس نظامًا جامدا بل صالح لكل زمان ومكان وقادر على مواكبة تطور العصور وتبني ما ينتجه العقل البشري من نظم وأفكار ما دامت لا تتعارض مع أصوله التشريعية والأخلاقية.
ويبقى السؤال المعلق، الذي ينبع من هذه السجالات الفكرية، هو: لماذا، ورغم مرور الزمن، ما زالت الدول العربية الحديثة تفشل في تطبيق الديمقراطية التي لا تتجاوز في أحسن أحوالها زينة سياسية في الدول التي أعلنت تبنيها؟ فهل الخلل في بنية الأنظمة الحاكمة الأوتوقراطية، أم في التركيبة الاجتماعية والسياسية للمجتمعات ذاتها، أم هو خلل خارجي، أم مرتبط بإرادة الاستعمار المتقنع بأقنعة مختلفة؟
هنا تبرز أطروحة المفكر اليهودي إسرائيل شاحاك من قاعات "الجامعة العبرية" في القدس، حيث قدم في كتابه "أسرار مكشوفة" إجابة تبدو جزئية لكنها بالغة الأهمية، إذ يؤكد أن إسرائيل والحركة الصهيونية تعارضان بقوة تحول المجتمعات العربية إلى الديمقراطية وتخشيان من ذلك. فكلما كان النظام العربي فاسدًا في قيادته ومجتمعه ازداد احتمال تعاون إسرائيل معه أو دعمها له. وتدرك إسرائيل أن أي نظام ديمقراطي عربي سيكون أقوى بكثير من النظام الأوتوقراطي حتى لو كان يحظى بشعبية مؤقتة. ويضيف شاحاك أن معارضة أمريكا لتحول الأنظمة العربية إلى أنظمة ديمقراطية تعزى بشكل أساسي إلى سياستها الرامية لإبقاء هذه المجتمعات ضعيفة ومفككة حماية لمصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
وهكذا تبرز إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي كنتاج لتفاعل معقد ومؤلم بين عوامل داخلية وخارجية. فالعوامل الداخلية تتعلق ببنية الأنظمة والأنماط الاجتماعية والعلاقة المعقدة بين التراث والحداثة، فيما تمارس قوى إقليمية ودولية تأثيرًا قد يحول دون تحول ديمقراطي حقيقي قد يهدد مصالحها. وتبقى الإرادة المجتمعية والوعي الجماعي رهينتين بتوازن القوى هذا، مما يجعل الديمقراطية في أحسن حالاتها مجرد واجهة شكلية تفتقد الجوهر الحقيقي للممارسة السياسية الفاعلة، فيظل الحلم بالديمقراطية الخالصة معلقا بين مصالح ورغبات القوى الخارجية وعجز وهوى الأنظمة الداخلية واستبداد الماضي بالحاضر واختصار المستقبل بمقولة العامة المشهورة: "عيّشني اليوم وموّتني بكرا"...