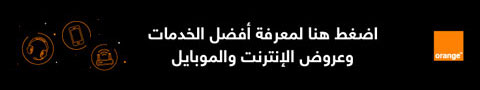أمجد الفاهوم يكتب:رواية رجال في الشمس

نبأ الأردن -
الأستاذ الدكتور أمجد الفاهوم
تتجدّد أهمية الأدب الذي يضع الإنسان في مواجهة أسئلته الكبرى كلّما تعقّدت الخيارات وضاق الهامش بين النجاة والكرامة. فالروايات التي تعيش طويلًا لا تفعل ذلك لأنها تحكي قصة فحسب، بل لأنها تكشف آليات إنسانية تتكرّر عبر الأزمنة. ومن هنا تبرز رواية رجال في الشمس لـ غسان كنفاني بوصفها نصًا لا يتقادم؛ لأنها لا تتناول مأساة الهجرة وحدها، بل تُعرّي ثمن الصمت حين يتحوّل إلى خيار، وتكشف كيف يمكن لغياب الصوت أن يكون قاتلًا مثل غياب الهواء.
ينطلق هذا المقال من جوهر الرواية: ثلاثة رجال يختارون الصمت داخل صهريجٍ مغلق أملًا بالعبور، فينتهي بهم الأمر إلى موتٍ صامت. ليست المأساة في الصحراء وحدها، ولا في قسوة الطريق، بل في القبول بالصمت بوصفه وسيلة للنجاة. هذا المعنى يتجاوز السياق السياسي المباشر للرواية، ليطرح سؤالًا إنسانيًا أوسع: ماذا يحدث حين يعتاد الإنسان الصمت أمام الخطر، أو الظلم، أو الإقصاء، حتى يصبح الصمت استراتيجية حياة؟
تزداد أهمية هذا الطرح اليوم لأن الصمت لم يعد دائمًا مفروضًا بالقوة؛ بل يُختار أحيانًا بدافع الخوف، أو التعب، أو فقدان الأمل في التغيير. وفي مجتمعاتٍ تواجه ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متراكمة، قد يبدو الصمت ملاذًا نفسيًا مؤقتًا، لكنه يحمل كلفة باهظة على المدى الطويل. وهنا تكتسب الرواية بعدها التحذيري، إذ تُظهر أن الصمت يمنح شعورًا زائفًا بالأمان، لكنه لا يوفّر النجاة.
تعتمد قراءة هذا المقال للرواية بوصفها نموذجًا فكريًا لا شهادةً تاريخية فحسب. فهي تستخرج من السرد آليةً متكرّرة: حين يُختزل الإنسان في هدفٍ واحد—العبور، النجاة، الخلاص—قد يضحّي بصوته، ويؤجّل اعتراضه، ويقايض كرامته بالصبر. وتتيح هذه المقاربة ربط الرواية بسياقات معاصرة دون إسقاطٍ قسري أو خطابٍ وعظي.
عربيًا، شكّلت الرواية مرجعًا ثقافيًا في فهم علاقة الفرد بالسلطة، وبالظرف القاهر، وبفكرة الانتظار. وقد استُحضرت في نقاشاتٍ فكرية لتفسير كيف يتحوّل القهر المزمن إلى تطبيعٍ مع الصمت، وكيف تُعاد إنتاج المأساة حين يُغلق الفضاء العام أمام التعبير. وتُظهر تجارب عربية حديثة أن المجتمعات التي طال فيها أمد الصمت دفعت ثمنًا اجتماعيًا ونفسيًا، حتى عندما لم يكن الصمت سياسيًا بالمعنى المباشر.
دوليًا، تتقاطع رسالة الرواية مع تجارب إنسانية أخرى؛ إذ أظهرت دراسات اجتماعية أن الصمت الجماعي أمام المخاطر—في بيئات العمل، أو المؤسسات، أو الأزمات الصحية—يسهم في تفاقم الخسائر. وكشفت تجارب عالمية أن غياب قنوات التعبير، أو الخوف من العواقب، يدفع الأفراد إلى كبت التحذير، فتقع كوارث كان يمكن تجنّبها لو كُسر الصمت في الوقت المناسب.
محليًا، وفي السياق الأردني، يمكن قراءة الرواية من زاوية اجتماعية ومهنية أيضًا. فالصمت لا يظهر فقط في القضايا الكبرى، بل في التفاصيل اليومية: موظف لا يعبّر عن مشكلةٍ تتفاقم، شاب لا يطلب الدعم حتى يستنزف، مؤسسة تتجاهل إنذاراتٍ مبكرة فتدفع ثمنًا مضاعفًا لاحقًا. وقد أظهرت تجارب محلية أن فتح قنوات الحوار والإصغاء المبكر يقلّلان من الكلفة الإنسانية والإدارية للأزمات.
تقود هذه القراءة إلى نتائج تستحق النقاش: أولها أن الصمت قد يكون مفهومًا نفسيًا في لحظة الخوف، لكنه يصبح خطرًا حين يتحوّل إلى نمطٍ دائم. وثانيها أن غياب الصوت لا يحمي الإنسان من النتائج، بل يؤجّلها ويضاعفها. وثالثها أن المجتمعات والمؤسسات التي لا تُنصت لإشارات التحذير المبكرة تعيد إنتاج المأساة بأشكالٍ مختلفة.
غير أن كسر الصمت لا يعني الصراخ ولا المواجهة غير المحسوبة؛ بل يتطلّب بناء مساحاتٍ آمنة للتعبير، وثقافةً تُقدّر السؤال والتحذير، وتفصل بين النقد والتجريح. كما يتطلّب شجاعة فردية وجماعية للاعتراف بأن الصمت ليس دائمًا حكمة، وأن الكلام في الوقت المناسب قد يكون فعل إنقاذ.
ويخلص هذا الطرح إلى استنتاجٍ جامع: إن الرواية لا تسأل لماذا ماتوا فقط، بل لماذا صمتوا. فهي تذكّرنا بأن النجاة لا تتحقّق بالسكوت عن الخطر، وأن الصوت—مهما بدا ضعيفًا—قد يكون الفارق بين الحياة والمأساة. وحين يدرك الإنسان أن للصمت ثمنًا، يصبح الكلام الواعي مسؤوليةً لا ردّ فعل.