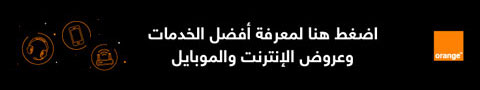نسيم بلهول يكتب: "خلف الستار التركي: حين تتحول "الدبلوماسية العلمية" إلى أداة لاختراق العقول"

نبأ الأردن -
مقدمة: من مشروع أكاديمي إلى سؤال حول الأجندة
في عالم يزداد فيه التداخل بين الأكاديمي والسياسي، وبين المبادرات المعرفية والمشاريع العابرة للحدود، تصبح التجربة الشخصية أحيانًا بوابة لإعادة التفكير في ما يبدو ظاهره أكاديميًا محضًا. هكذا بدأت تجربتي عندما شاركت، بشكل تطوعي، في تأطير إحدى الدورات التدريبية التي نظّمتها جهة تُعرّف نفسها باسم "أكاديمية العلاقات الدولية" في تركيا.
كان المشروع يحمل عنوانًا واعدًا: "دبلوم الإستخبارات"، وهو مجال نادر الوجود في الأكاديميات العربية، ويستحق التطوير، خاصة من منظور علمي مدني. لكن مع تتابع المراحل، بدأت تظهر مؤشرات تستدعي الحذر: غموض في التمويل، توجهات فكرية غير متوازنة، انتقائية في المحتوى، وميل واضح لتأطير المشاركين داخل رؤية أيديولوجية لا تتماشى مع الحياد العلمي أو احترام سيادة الدول.
مراكز التدريب الناعمة: العلم في خدمة مشروع سياسي؟
ما أثار الريبة ليس فقط ضعف الخلفية الأكاديمية لبعض من تم تقديمهم كخبراء، بل طريقة إدارة الحوار وتوجيهه نحو تشكيك مستمر في شرعية المؤسسات العربية، وربط أزمات بعض الدول برؤية "مضادة للدولة الوطنية".
الخطاب المقدم، وإن تزيّن بعبارات مثل "بناء الوعي"، "التكوين الإستراتيجي"، و"النهضة"، كان في كثير من الأحيان يحمل سرديات مألوفة لدى الدارسين لتاريخ الحركات الحركية العابرة، خاصة تلك المرتبطة بالإسلام السياسي. فباسم "أخلاقيات الإستخبارات"، كانت تُعاد صياغة قضايا حساسة، بطريقة تقود المشاركين – بشكل غير مباشر – إلى التشكيك في الهويات الوطنية، والتماهي مع مشروع "أممي" ذي طبيعة غير واضحة المعالم.
الإخفاق في الشفافية: من التمويل إلى الأجندة
رغم الطابع الإحترافي الخارجي للأكاديمية، من شهادات مرقّمة ومنصات رقمية جذابة، لم يكن هناك وضوح كافٍ حول مصادر التمويل، ولا معايير اختيار المؤطرين أو المدربين. بل إن بعض المشاركين لاحظوا أن أغلب المؤطرين كانوا من جنسيات عربية لا يُعرف لهم نشاط أكاديمي موثّق، بينما تم تضخيم أدوارهم ضمن البرنامج.
في المقابل، لم يكن هناك أي توازن في التمثيل العربي الحقيقي، ولا ضمانات لسلامة الطرح العلمي، بل بدا واضحًا أن الهدف الحقيقي يكمن في استقطاب شباب عربي باحث، وإعادة تشكيل وعيه ضمن سردية معينة، ذات صلة بمشروع سياسي يدور في فلك تركيا ما بعد 2011.
من التكوين إلى التأطير: أسلوب باطني في خطاب ناعم
لم يكن غريبًا أن تستنسخ هذه التجربة بعض آليات التنظيمات المغلقة: خطاب عاطفي، إحالة إلى "الضحية الجماعية"، إحساس بالمظلومية، ثم تقديم "البديل الحضاري". هي نفس البنية النفسية التي تشتغل بها تيارات غير تقليدية، تسعى لإعادة إنتاج شبكات فكرية وثقافية مرتبطة بأطروحة تتجاوز حدود الدولة وتعمل على إعادة تشكيل النخب الناشئة في المنطقة.
موقف شخصي: بين الإعتذار واليقظة
لا أكتب اليوم لتصفية حساب، ولا لتوجيه اتهامات، بل لتقديم تجربة أراها مهمة للأجيال الجديدة من الباحثين. كنت ممن ساهم في إحدى تلك الدورات، بدافع علمي بحت، وحرصًا على تقديم رؤية معرفية دقيقة في موضوع أمني شديد الحساسية. لكن حين أدركت التوجه العام، وانكشف لي المسار، انسحبت بصمت.
لم يكن هناك مقابل مادي ولا رغبة في شهرة. بل التزام أخلاقي تجاه المعرفة، والوطن، والإنسان العربي.
دور الدول العربية: الغائب الأكبر
المؤلم في هذه التجربة ليس فقط ما تم داخل تلك الأكاديمية، بل الغياب العربي عن رسم سياسات واضحة تجاه مثل هذه المبادرات. فلا توجد حتى الآن قوائم تحذيرية من المراكز ذات الطابع الملتبس، ولا إشراف أكاديمي إقليمي يضبط آليات التكوين الموازي الذي يُقدم أحيانًا للباحثين العرب على أنه "فرصة نادرة".
والنتيجة: مؤسسات تُدار من الخارج، بخطاب داخلي، بأسماء عربية، وبأجندات قد لا تخدم الإستقرار الفكري ولا الأمن المعرفي في المنطقة.
خاتمة: المعرفة مسؤولية.. لا منصة للتوظيف
في زمن تتعدد فيه أشكال التأثير، يصبح "الإختراق الناعم" أخطر من الضربات المباشرة. فحين تتحول الأكاديميا إلى قناة لبث مفاهيم مغلوطة، وتُستخدم الأدوات العلمية في تقويض مفاهيم السيادة، يكون من الضروري أن نتحدث.
هذه شهادة شخصية، لكنها دعوة مفتوحة للباحثين، للمؤسسات، ولصنّاع القرار، كي يعيدوا النظر في "الدبلوماسية العلمية" عندما تتحول من جسر للتفاهم، إلى أداة للإختراق. فلا "دبلوم استخبارات" يُعوّض خسارة العقل، ولا أي ليرة تُعوّض ضياع البوصلة.