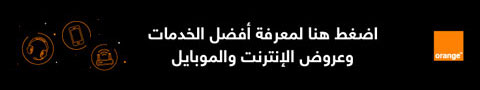د. ماجد الخواجا يكتب: المكتبة الوطنية حارسة الذاكرة الإنسانية (2)

نبأ الأردن -
استكمالاً للحديث عن واقع ومستقبل المكتبات في ظل الرقمنة الطاغية التي استباحت كافة الموروثات والمسلمات والتفاصيل المجتمعية.
حين أدخل إلى قاعة الدرس، لم أعد أطلب من الطلبة أن يفتحوا دفاترهم وكتبهم وأن يكتبوا بأقلامهم شيئاً، فلا قلم ولا دفتر ولا كتاب يحملون. تمرّ أمامنا أفواج وأفواج لم تعد تشاهد بيديهم غير الموبايل.
أثناء المراقبة على الاختبارات للطلبة، أطلب ضمن الإرشادات القبلية والبعدية أي ما قبل وبعد تأدية الإختبار، وضع جهاز الجوال على الطاولة، وعندما ينهون أذكرهم بأن لا ينسوا جوالاتهم، ولم يعد من كلمات من قبيل أن يضعوا كتبهم ودفاترهم وأن لا ينسوها، فهي أصبحت من الكلمات المندثرة ذات الشكل التراثي.
لم يعد مشاهداً في الحرم الجامعي وأعني حرم كل الجامعات أولئك الطلبة الذين يحملون كتاباً أو دفتراً أو حقيبةً، فقط هو جهاز الموبايل اللعين الذي أصبح امتداداً لليد، وفي أحسن الحالات يكون ما يدعى الآيباد أو اللاب توب هو المرافق للطالب والأستاذ. تماماً كما كانت الحالة مع الفلاح المزارع عندما كانت الفأس هي الامتداد لليد، لكن الفأس كانت تضرب الأرض فينتج الزرع والمحصول، فيما الموبايل الذي هو امتداد اليد الآن، فلا ينتج غير كثيرٍ من المحاصيل السيئة الرديئة غير الأخلاقية، والعبثية والتافهة السارقة للوقت والعقل والعاطفة.
لم تعد ترى الطلبة الذين كنا نسميهم « دود القراءة» أولئك الذين كانوا يخرجون من المحاضرة إلى المكتبة حتى أن منهم من تعتاد على وجوده في زاوية وطاولة محددتين. لم تعد أبواب المكتبات تستقبل كثيراً من الطلبة الذين كنا نشاهدهم بين رفوف المكتبة منهمكين في البحث عن عنوان أو كتاب بعينه، كانت الإستعارة لا تزيد عن أسبوع أو أسبوعين عند التمديد. نعم ربما كانت البيئة الفيزيقية للمكتبات ليست منشرحة أو مرحبة بالأفراد بكل ما يحملونه من هواجس ونزق وروح شبابية وثابة وربما حماقات وصخب وعبثية مقترنة بأهوائهم وأمزجتهم وأعمارهم، فهي لها معايير صارمة أولها التزام الصمت والهدوء والحركة بتؤدة دون جلبة أو إحداث أي تشويش على المطالعين، وثانيها عدم ممارسة أية سلوكات خارجة عن الأعراف المكتبية من قبيل تناول الطعام والشراب والتحدث بالهاتف أو مع الزملاء والزميلات، الجلوس على الطاولات، تناول الكتب عن الأرفف وإعادتها لمكانها أو إبقائها على الطاولة والخروج كأثر الفراشة بلا أدنى جلبة. لا أمتلك أرقاماً دقيقة لكن أزعم أن أوائل الطلبة في كافة التخصصات هم غالباً ممن يرتادون المكتبة العامة ومكتبة الكلية، لكن لا يعني ذلك أنهم بالضرورة الأوسع ثقافة والأعمق فكراً وأدباً، إنما يعني أنهم تبحّروا وخاضوا في أعماق الكتب المختصة بمجالاتهم المعرفية التخصصية. كان دائماً ثمة أفراد من الطلبة تجدهم يسيرون وهم يحملون كتاباً ذا طابع فلسفي أو وجودي أو جدالي، وكانوا يحتلون زاوية أو ركن في كافتيريا الكلية، أو على المقاعد المتناثرة وسط الأشجار في الجامعة، أولئك هم نواة المثقفين وأنصاف المثقفين الكادحين والجاهزين لمشاريع ثورية وثقافية مع بؤس واضح في الحالة المادية وإهمال في المظهر العام وربما مع إطلاق اللحى دون تشذيب وهندام يطغى عليه حضور بنطال الجينز الشهير، وروح منطلقة باحثة عن عوالم مرسومة في مخيال اجتماعي متناقض مع واقع متشظي لا ينساق وأحلام أولئك الشباب. هكذا ترافقت الهندسة مع الأدب، الطب مع الفلسفة، العلوم مع الأيديولوجيا. هكذا تواصل الحياة إنتاج فعالياتها ومناشطها وشخوصها، يتوالدون كأنهم من جينٍ واحدٍ، تتعاقب العصور والأجيال وتتطور الأدوات والمعرفة، لكنهم بأرقهم نحو إنسانيةٍ فضلى يأخذون صفة الاستمرارية والديمومة والإمتداد عبر الزمن البشري والتاريخي كبصمةٍ ووسمٍ ونكهةٍ تمنح الحياة رونقها الخاص.
كنت أراقب على طلبة يقدمون امتحاناً في مختبرات حاسوبية، وجدت أنني بعفوية أطلب منهم أن يضعوا هواتفهم الخليوية على الصامت وأن يضعوا هوياتهم الجامعية على طاولة الامتحان، وعند الخروج كنت أيضاً بعفوية أطلب منهم أن لا ينسوا هواتفهم وهوياتهم، ولم يخطر لي ببال أن أطلب منهم عدم نسيان كتاب أو دفتر.
هو حديث قد يطول في مراجعات وتأملات التحولات الحياتية التي نعيشها، تحولات أوصلتنا إلى التخلّي عن كثيرٍ مما كنا نعتقد أنها مسلمات وبدهيات ومبادئ لا يمكن الاستغناء عنها.
مع ذلك تبقى المكتبات وخاصة الوطنية لها مهام وعليها أدوار غاية في الأهمية، من حيث أرشفة الذاكرة الوطنية وصيانتها وحراستها. لكن ذلك يستدعي العمل على مواكبة ومجاراة التغيير الرقمي الهائل لتصبح المكتبات بلا رفوف وبلا جدران وبلا أوقات محددة، مكتبات ذات بيئة صديقة إيجابية منفتحة يمكن دخولها والخروج منها بفرح وبقيمة مضافة