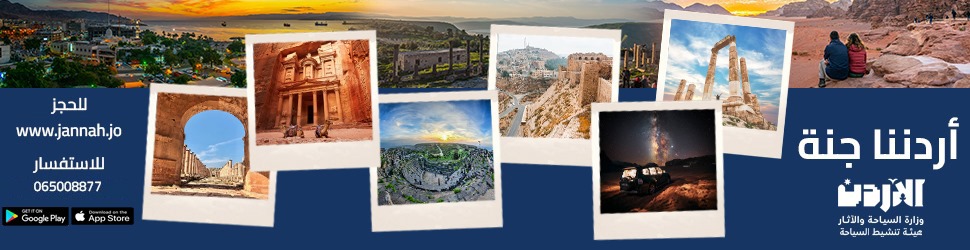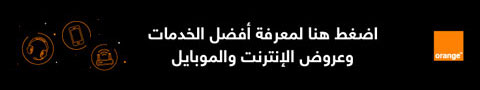د.حسن براري يكتب : لا أدري إن اتعبت عقلي أم أتعبني .. من المنتصر ومن المهزوم ولماذا؟!

نبأ الأردن -
كنت أترقب بحذر لقاء منهج جديد لم أعتده من قبل. كان اسم الدرس "التفكيك" Deconstruction وكأنما هو دعوة سرية إلى كسر قوالب الفكر التقليدية التي غرستها مدارسنا فينا (أو للدقة التنشئة الاجتماعية بأركانها الخمس)، حيث تلقين المعارف دون تساؤل أو نقد.
كان الجو مثقلاً بالإثارة الفكرية، وكأن قاعة المحاضرة تتنفس أسئلة تنتظر الإجابات الشجاعة. كنت قد فرغت من قراءة الأبحاث والكتب المطلوبة قبل المحاضرة وفي عقلي تدور أسئلة جوهرية كنت أعتقد قبل ذلك أن مجرد طرحها بدعة!
فمنهج التفكيك في العلوم الاجتماعية هو منهج نقدي نشأ في الفلسفة على يد جاك دريدا، ويستخدم لفحص النصوص والأفكار والأنظمة الاجتماعية والثقافية بهدف تحليل الافتراضات الضمنية والهياكل الخفية التي تشكل فهمنا للعالم. وهو ليس عملية تدمير أو إنكار للأفكار، بل هو إعادة النظر فيها بطريقة تكشف التحيزات، التناقضات، والأبعاد غير المرئية التي تكمن وراءها.، ويركز على فكرة أن اللغة والأفكار ليست بريئة أو ثابتة، بل مشحونة بمعانٍ تتغير وفق السياق الثقافي والتاريخي.
في تلك المحاضرة، كانت بيننا طالبة لبنانية ترتدي قبعة كبيرة ربما للحماية من برد بريطانيا على الرغم من أن القاعة دافئة، وهي العربية الوحيدة معنا. قدمت مداخلة لتطبيق المنهج على المعاني السياسية المتأصلة في النظام التوافقي الطائفي في لبنان رافعةً وجهة نظر طائفتها كحقيقة مطلقة. وحينما سألها زميل هولندي، وهو الآن صديق مقرب لي، عن وجهة نظر مغايرة، انفجرت غضبًا قائلة: "لا أسمح لك!" كانت ردة فعلها حادة، جعلتنا نضحك مطولا، ليحمر وجهها وتقدم اعتذارها. تلك اللحظة كانت درسًا بحد ذاته، فالعلوم الاجتماعية ليست قلاعًا صماء، بل أراضٍ خصبة تتعايش فيها تناقضات وتنوعات، ولا يمكن لأي مقاربة أن تدعي الكمال. أدركت حينها أنني كنت في رحلة فكرية خارج منطقة الراحة (comfort zone) حيث تدفع العقول الكسولة إلى يقظة مطلوبة.
من نعم الله التي لا تحصى أنني عشت تجربة في سياق ثقافي مغاير، جعلني أتبصر في معاني النقد والتجديد، وأدرك أن التقدم يبدأ حين تتعلم أن تسأل. لا يتطلب الأمر كثيرا، فقراءة إرونسوا لاكلاو تجعلك تعيد النظر في ما يفهمه الكثيرون بأنه مبادئ أو حتى "أصالة". فوفقا له – وهنا أتفق معه – لا توجد أصالة أو مبادئ في ذاتها كجوهر ثابت أو موضوعي، فالمعاني والقيم التي نعتبرها "أصيلة" تتشكل من خلال الخطابات الاجتماعية والثقافية، وعليه فإن الخطاب هو أداة لإعادة بناء الواقع، ولا يعكس حقيقة "أصيلة"، بل يُنتجها. هذا يعني أن الأصالة ليست معطى سابقًا، بل نتيجة للصراعات الخطابية التي تحدد ما يُعتبر "أصيلاً" وما لا يُعتبر كذلك.
في العالم العربي، نفتقد كثيرا الجرأة لطرح السؤال الجوهري، ذلك الذي يهز أركان مسلماتنا ويجبرنا على إعادة التفكير في ما نعتبره "أصيلاً" أو "مطلقًا". ربما لأن الخروج من نطاق الراحة يهدد استقرارًا زائفًا اعتدنا عليه، أو لأن طرح الأسئلة الصعبة مكلف، ليس فقط على المستوى الفكري بل أيضًا على المستوى الاجتماعي والسياسي. في خضم ذلك، نجد أنفسنا عالقين في سرديات جاهزة عن "النصر" و"الهزيمة"، وعن "الدعم" و"التخاذل"، حيث تتحول هذه المفاهيم إلى أدوات خطابية تُستخدم للتبرير بدلاً من التفكير.
تمامًا كما أشار لاكلاو إلى أن الأصالة تُبنى عبر صراعات خطابية وليست حقيقة مطلقة، كذلك فإن مفاهيم النصر والهزيمة لدينا ليست سوى نتاج لخطابات تُعزز مصالح معينة وتخفي تناقضاتنا. نحن بحاجة إلى شجاعة نقد الذات وتفكيك هذه السرديات لفهم أعمق لواقعنا؛ فهم لا يقدّم إجابات جاهزة، بل يفتح آفاقًا جديدة للتفكير في علاقتنا بالآخر وبأنفسنا. وهذا، وإن كان مؤلمًا، هو الخطوة الأولى نحو التقدم.
وبعد كل ذلك ما زال الحوار لدينا مكاسرة!!!!