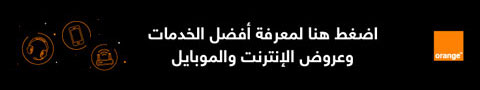عريب الرنتاوي يكتب: عباس ومهلة السنة الأخيرة: إمهال لإسرائيل أم استمهال للرحيل؟

في كلمته أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس مدفوعاً بالتقارير والبيانات التي تتحدث عن تآكل "شرعية" السلطة و"شعبيتها" بعد أن طالب 80 بالمئة من أبنائه وبناته، باستقالة الرئيس وتنحيه … الشعب الفلسطيني كان "المُخَاطب" بهذا الخطاب، أكثر من المجتمع الدولي…الرئيس الذي سبق له أن صرح بتخليه عن حقه في العودة إلى بلدته الأصلية "صفد" المحتلة عام 1948، استذكرها كما لم يفعل من قبل، مُدَعماً هذا الحق بوثائق عرضها على الملأ، مؤكداً أن هذا الحق، يشمل سبعة ملايين لاجئ فلسطيني.
انتفاضة القدس والشتات ويقظة حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، حضرت بدورها في الخطاب المذكور، تلك الانتفاضة غير المسبوقة، التي أعادت الاعتبار لوحدة الشعب وقضيته، وهي ذاتها الانتفاضة التي رأى أقل من عشرة بالمائة من الفلسطينيين، بأن أداء الرئيس خلالها كان مرضياً.
وفي خضم التصريحات والتكهنات (والاتهامات) حول أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قضية "الفرسان الستة" الذي كسروا هيبة "جلبوع" والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، جاء الخطاب ليكرر في أكثر من موقع، التزام السلطة برعاية أسر الشهداء والأسرى، وجاءت تحياته المتكررة أيضاً، لانتفاضة الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة.
الرئيس وفريقه، أملِا على ما يبدو، في "جبر الضرر" الذي لحق بصورته وصورة السلطة جراء الأداء الضعيف (اقرأ المتخاذل) زمن انتفاضة القدس وسيفها وما تلاهما، وهذا أمرٌ مفهوم على أية حال.
في خلفية المشهد، أربع صور تختصر رحلة المئة عام الأخيرة من كفاح شعب فلسطين، من فلسطين التاريخية إلى خريطتي التقسيم و67، وصولاً إلى خريطة العام 2020 التي لم تُبِق للفلسطينيين سوى 12 بالمئة من أرضهم، و"الحبل على الجرار".
وسيستجمع الرئيس قدراته "البلاغية"، وهو لا تنقصه البلاغة على أية حال، في توصيف الصلف والغرور الإسرائيليين، وتقديم الشواهد على "مروق" إسرائيل وعنصريتها ونهمها الاستيطاني التوسعي، ومعايير المجتمع الدولي المزدوجة، وفشله المتكرر في حل المشكلة الفلسطينية برغم كل ما أبداه الرئيس ومن سبقه، من تعاون واستعداد للقبول "بالهم الذي لم يقبل بنا"، وصولاً لصيحة "حلّو عنا" التي أنهى بها كلمته المنتظرة.
لكن الرئيس كما كان متوقعاً، تفادى الإشارة إلى مسؤولية القيادة الفلسطينية عن "الفشل المتكرر والمتراكم" في الوصول إلى حلٍ يحفظ الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين المشروعة، ومسؤوليته الشخصية عن هذا الفشل، منذ أن تولى موقعه ككبيرٍ للمفاوضين في أوسلو، مروراً بموقعه المتقدم في منظومة السلطة والقيادة، وبعد ستة عشر عاماً قضاها على رأس الهرم القيادي الفلسطيني … ثمة فشل لا يليق بقائد فلسطيني أن يُلقي به على كاهل الآخرين فقط، سيما وأننا نتحدث عن ثلاثين عاماً على "مدريد – أوسلو"، وأزيد من ربع قرن على قيام السلطة، وهي مسيرة كانت حافلة بالمستوطنات والمستوطنين، بالأسرلة والتهويد والضم والابتلاع والتشريد وهدم المنازل والابارتيد.
بدا الرئيس كمن يودع حقبة كاملة في تاريخ النضال الفلسطيني، قادها هو شخصياً، أو على الأقل، قاد منفرداً فصلاً طويلاً منها، لكنه آثر على عادته، خيار "التمديد للفشل" لسنة إضافية، ولا أدري إن كان بتلويحه سحب الاعتراف بإسرائيل (تلويح وليس تصريح)، قد مدد سنة إضافية للوهم والفشل، أم أنه كان يمدد لنفسه سنة أخرى؟ تلكم قضية يصعب الجزم بها من بعيد.
لكنه وهو "ينعي" مرحلة وحقبة، أو يصوغ بطاقة نعيها، تركنا وشعبه، في حيرة من أمرنا، فهو وضع كافة الاحتمالات على الطاولة، من بينها العودة لقرار التقسيم (181)، لكأن من فشل في انتزاع مندرجات القرار 242، و22 بالمئة من أرض فلسطين، سيكون قادراً على ترجمة القرار 181، واسترداد 44 بالمئة من أرض فلسطين التاريخية … تلكم أحجية لا بد من تفكيك طلاسمها.
على أنه أبقى الباب مفتوحاً لخيار تمليه الوقائع الإسرائيلية الصلبة المفروضة على الأرض، خيار "الدولة الواحدة"، العنصرية بامتياز، معرباً عن استعداده واستعداد شعبه، لمواصلة مشوار التضحية والنضال حتى انتزع الحرية والحقوق والكرامة، ملوحاً للمرة (لا أدري) بالمضي قدما في انتزاع عضويات المنظمات الدولية، والاحتكام لـ"العدل الدولية"، طالباً للمرة (لا أدري) حماية دولية مناسبة لشعبه الرازح تحت نير الاحتلال.
وعلى الرغم من نبرة "التصعيد" و"رفع السقف" التي انطوى عليها الخطاب، إلا أنه فشل في رسم خريطة لشعبه، مكتفياً بتوصيف المأزق واستعراض مراحل الفشل والخيبة و"سقوط الرهانات والأوهام"، وأحسب أن التوصيف والتكهن، هي من وظائف "المحلل السياسي" ولا أرى أنها وظيفة القائد السياسي، سيما في لحظات انعطاف تاريخية، كتلك التي تمر بها فلسطين شعباً وقضية وحركة ومشروعاً.
أما الفصل الأكثر "مراوغة" في الخطاب، فذاك المتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي … هنا تبرز الانتخابات البلدية والنقابية كبديل عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المعلقة على شرط رفع "الفيتو" الإسرائيلي إجرائها في القدس الشرقية، هنا أحاديث عن احترام منظومة الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، من دون أن يقترن ذلك بمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والارتكابات … هنا سعي محموم للتغطية على الشروخ الغائرة التي لحقت بصورة السلطة منذ تصفية نزار بنات وحتى يومنا هذا.
لا أفق ارتسم في خطاب الرئيس حول "دمقرطة" و"تشبيب" القيادة الفلسطينية واستعادة شرعيتها الشعبية … لا أفق منظور لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة …أما الحديث عن حكومة وطنية جامعة، فلا يخرج عن "لزوم ما لا يلزم".
لم يخبرنا الرئيس بالذي سيفعله في السنة الأخيرة قبل "التحوّل الكبير" في النهج والمقاربة، من الآن وحتى نهاية المهلة الممنوحة لإسرائيل لإنهاء احتلالها وإنفاذ "حل الدولتين"، ما الذي سيفعله الرئيس والسلطة والشعب غير الانخراط في مسار "استعادة الثقة" مع الجانب الإسرائيلي، هل ينتوي تهيئة التربة لانتقال سلسل للسلطة والقيادة؟ هل ينتوي الاعتراف بالفشل والتنحي لصالح قيادة جديدة؟ … ما الذي سيفعله بخصوص "المقاومة الشعبية السلمية"، والمصالحة الوطنية، وإعادة بعث حركة فتح وتوحيدها، تعزيز صمود الأهل على الأرض وتطوير مقاومتهم، ما الذي سيفعله من الآن، وحتى موعد الخطاب القادم في نيويورك، هل ثمة جديد سيبوح به الرئيس في قادمات الأيام، وأمسك عن قوله من على منصة الأمم المتحدة، أم أننا سنقضي الوقت في انتظار ما ستفعله إسرائيل، كما اعتدنا في السنوات الأخيرة؟ هل يظن الرئيس حقاً أن "الأدرينالين" قد سال مدراراً في عروق الإسرائيليين والأمريكيين وأعوانهم في العالم العربي بعد الخطاب وفي إثره؟
الاعتراف بفشل مسار مدريد – أوسلو، كان طافحاً من بين كلمات وسطور الخطاب الرئاسي السنوي، لكنه اعتراف مقرون بالعجز واليأس و"اللا-أدرية"، ولا تقلل العبارات الغاضبة والصاخبة من شأن هذه الحقيقة المرة، وأخشى ما أخشاه، أن تكون مهلة العام الإضافي، التي منحها الرئيس لهذا المسار، هي مهلة شخصية له قبل أن يقرر نهائياً بشأن موقعه وموقفه، فالرجل الذي قاد حقبة في تاريخ النضال الفلسطيني، لم يعد قادراً، وهو في هذا العمر، لتدشين حقبة جديدة، أكثر صعوبة، وأشد خطورة.