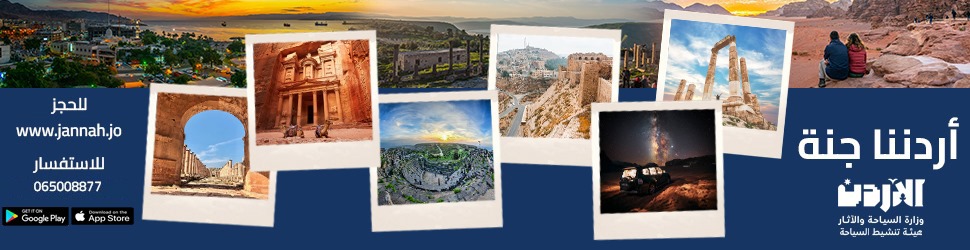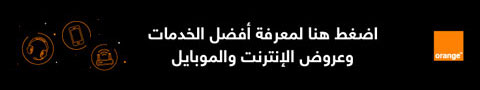د. ماجد الخواجا يكتب: البحث العلمي في العالم العربي

نبأ الأردن -
ثمة عبارة تقول Think Global & Act Local، فكّر عالمياً ونفّذ محلياً، ويبدو أن انتشار الرقمنة ووصولها إلى قاعات الدرس والتجربة والتحليل والبحث، أتاح نوعاً من الإنكشاف لم تعد معها تنطلي على أحد حكايات التخفّي والمواربة وعدم الوضوح.
ابتداء لنعترف أن مؤشرات التصنيف العالمية للجامعات وعملياتها ليست بريئة تماماً، وقد لا تعبّر عن الواقع مقارنةً بالتصنيف لها، وهذه الحالة لا تقتصر على الجامعات، وإنما تمتد لأية مؤشرات تقييمية في أية مجالاتٍ مجتمعية، حيث تميل الإدارة المشاركة في التصنيف إلى تشكيل اللجان المختلفة التي غاياتها موائمة الأوضاع بما يلبّي مطالب المؤشرات، فتنطلق الجهود المبذولة لتلبية تلك المتطلبات، وتحصد الترتيب غالباً تبعاً لدقة تحقيق المستهدفات من معايير المؤشرات، ولا تعبّر عن حقيقة ما يجري على أرض الواقع. وهذا يصبح مفهوماً ومبرراً في ظلّ تسليط سيف التصنيفات العالمية على رقاب الجامعات واعتبارها جزءاً أساسياً في تقييم الإدارة الجامعية أيضاً. ناهيك عن تسييس التصنيفات والمؤشرات التي تتدخل في إضفاء قيمة ومكانة علمية مرموقة لجامعاتٍ بعينها ودولٍ تتداول الترتيب المتقدم في التصنيف.
ليكون البحث العلمي جزءاً رئيساً من عمليات التقييم والمؤشرات التصنيفية، بحكم أن أحد غايات الجامعات الرئيسة تتمثل في حجم ونوعية البحوث العلمية وموازناتها وتسهيلاتها وأثرها في المجتمع المحلي والعالمي.
إن المجتمعات الناميّة تهتزّ لأقل درجات التقييم أو التأشير على أي جانبٍ من جوانبها المجتمعية، فهي لا تمتلك الثقة الكافية للمواجهة والمجابهة فكيف بالتحدّي والمقارعة. لقد جاءت ما تدعى بمؤشرات النزاهة البحثية وترتيب الجامعات المحلية وعدم ورود أياً منها في المنطقة الخضراء أو البيضاء، فيما تكاد تكتظ وتزدحم بالجامعات الصهيوينة ذات التصنيف المتقدّم على مؤشرات النزاهة البحثية.
ثمة حالات ثلاث للتعامل مع مقاييس التصنيفات العالمية: الحالة الأولى تتمثل في إعطاء الأولوية لتلبية متطلبات التصنيفات، حتى تصير هاجساً وجزءاً من أولويات وخطط الجامعة، لدرجة يتم فيها ربط أية أهداف وتقييمها بمدى انسجامها مع أحد معايير المؤشرات التصنيفية، وهذا نشاهده في عديد من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة التي ربطت أداء عملياتها ومخرجاتها بمؤشرات حاكمة، قد تنطبق بشكلٍ كلّي أو جزئي أو لا تنطبق على المجتمع المحلي والوسط الذي تعمل به المؤسسة.
هنا يصبح عمل الجامعة / المؤسسة كأنه فقط لغايات تلبية متطلبات المؤشرات. فتنساق وتستدرج خلف تلك المؤشرات التي في المحصّلة لن تستطيع تحقيق قفزات هائلة تضعها في مراتب متقدمة، ليجيء السؤال: ماذا يترتب من عوائد على الترتيب والتصنيف للجامعة/ المؤسسة. إن المراجعات لموضوع الأيزو المتبّع كأسلوب لضبط وتقييم وإدارة الجودة، تظهر أنه بحكم المعايشة والألفة مع التصنيفات والتقييمات، يصبح لدى المؤسسة مستوى من الخبرة والدراية ليس بهدف التحسين الملموس الحقيقي، وإنما بهدف مجاراة التصنيفات، واعتبار مجرّد التقدّم الرقمي في الترتيب، كأن يكون ترتيبها للعام الماضي 546، فتحتل العام الحالي ترتيب 524، مجرّد رقم لا يعبّر عن أي شيء.
الحالة الثانية تتمثل في التحسين الجزئي البسيط غير المكلف، دون أن تصبح التصنيفات هاجساً وأولوية كبرى للجامعة / المؤسسة، وهذه الحالة تنطبق على نسبة كبيرة من الجهات المرتبطة بالتصنيف، والتي لا تمتلك القدرات لمجاراة متطلبات ومؤشرات التصنيفات، وتتبوأ مكانةً وترتيباً ضمن فئات ما فوق ودون المتوسط، بحيث أنه مهما فعلت من تحسينات، فهي لن تتجاوز في ترتيبها ما يستدعي أن تنفق الأموال والجهود والوقت لذلك. وهذا ينطبق عليه مقولة « إذا لم تكن في الصفّ الأول، فكل الصفوف التالية سواء»
أما الحالة الثالثة فهي الرافضة تماماً لفكرة التصنيف والتعليب، وأن تضع الجامعة/ المؤسسة مصيرها ومكانتها مرتهنة لإحصائيات وسلّم تقديرات يتغيّر سنوياً دون أدنى عائد من وراء ذلك التصنيف. هنا تنسجم الجامعة المؤسسة مع تحقيق غاياتها وأولوياتها وخططها دون الخشية من وقوعها تحت مصيدة التصنيفات.
كأنها اللعبة ذاتها في كثيرٍ من شؤون الحياة المجتمعية، عندما نتحدث عن المنحنى الطبيعي للأشياء، وحيث هناك 5% من المجتمع المستهدف يحصد الترتيب المتقدم، 90% يكون ترتيبهم ما فوق ودون المتوسط، 5% يقبعون في ذيل الترتيب. واللعبة تكمن في إيهام الغالبية وهم 90% من المستهدفين بالعمل على تلبية متطلبات التصنيف، لتستمر الدوامة بلا انتهاء لها. وللحديث صلة.