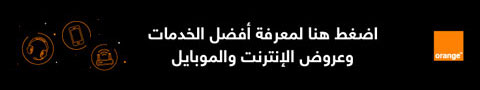سمير عبد الصمد يكتب: رسالة حب إلى "الرصيفة"

نبأ الأردن -
أنا الرُّصيفيُّ، وهي الرصيفةُ مسقطُ الرأسِ، ومسرحُ الطفولةِ، ومهوى الفؤاد، وميدانُ العشقِ الأولِ، ومَثوى الأحبةِ من الأهلِ والأصدقاءِ والرفقةِ الطيبةِ الذين قضت مشيئةُ اللهِ أن يرحلوا عن هذه الدنيا.
هي القَريةُ أو القُريَّةُ التي عاشت هادئةً هانئةً، مُسترخيةً على جانبي سيلِها الـمُتدفقةِ مياهُهُ طوالَ العامِ تقريبًا، كانت مزارعُها تَحفَلُ بكلِّ مُقوِّماتِ الحياةِ الريفيةِ من فواكهَ وخُضرواتٍ ومزروعاتٍ. تَتَعَربَشُ على جانبيهِ أشجارُ الدُّفلى (آه يا حيدر محمود، ما أجملَ شجرَ الدُّفلى على النهرِ يُغني!) والقُصيِّبِ وشُجيراتِ العُلَيِّقِ، التي كنَّا نَتحمَّلُ منها آلامَ الوخزِ والخدشِ لِنَجنيَ بعضًا من ثمارِها الناضجةِ، ولا نغادرُها إلَّا وأيادينا مُخَضَّبةٌ بلونٍ مُتورِدٍ من نَجيعٍ قانٍ.
هكذا هم المحبُّون، يَحتمِلونَ آلامَهم دونَ شكوى.
هي الحِضنُ الدافئُ الطيِّبُ، وجارةُ الوادي التي عشنا في مَغانيها الوادعةِ سنينَ حياتِنا الأولى، كان والدي الصارمُ ذو الشواربِ الكثيفةِ، يُوقظُنا قُبيلَ الفجرِ للعنايةِ بالمزرعةِ ومواشيها، كنَّا نُشفِقُ على والدتِنا النحيلةِ، وهي تجلسُ أمامَ تنورِها الشديدِ الحرارةِ، تُنضِجُ عجينَها لِيغدو خبزًا طازجًا نتناولُهُ على عجلٍ مع قليلٍ من اللبنِ والزعترِ وكوبَ شايٍ ساخنٍ، وما تَيسَّرَ من خيراتِ أرضِنا الطيبةِ، نحمَدُ اللهَ كثيرًا، قبلَ أن ننطلقَ مُهرولينَ، من منطقةِ (أم جرادة) في الشرقِ إلى وسطِ الرصيفةِ غربًا.
كنا نسيرُ إلى مدرستِنا الابتدائيةِ قاطعينَ مسافاتٍ بعيدةً، نَحثُّ الخُطى مُسرعينَ خوفًا من قرعِ الجرسِ الحديديِّ ذي الصوتِ المجلجلِ قبلَ وصولِنا، لا يُثنينا بردٌ قارسٌ أو حَرٌّ لاهبٌ، نجتازُ أحراشًا مُكتظةً بالأشجارِ الحَرَجيةِ، ومناطقَ مُقفرةً، عبرَ طُرقٍ ضيقةٍ مُتعَبَةً مُتعِبَةً، لِنحشرَ أجسادَنا على مَقاعدَ خشبيةٍ كبيرةٍ، تُطِلُّ منها رؤوسُنا الحليقةُ، نراقبُ لوحًا أسودَ عابسًا مُتهالِكًا، يتبخترُ أمامَه مُعلِّمٌ مُتَجَهِمٌ واثقُ القَسَماتِ، مُطمئنًا لسطوتِه وسُلطتِه، يُلوِّحُ أحيانًا بعصاه الغليظةِ، فتَـرتعِدُ لِـمَرآها فرائصُنا الطفوليةُ، وتجعلُ ذاكرتَنا تستعيدُ قولَ الأبِ الحازمِ: (لك اللحم، ولنا العظم)
بعدها انتقلنا إلى المدرسةِ الثانويةِ التي تقعُ في بقعةٍ مرتفعةٍ تُشرِفُ على معظمِ مناطقِ البلدةِ، كانت أكثرَ انضباطًا، وأكبرَ عددًا، وكان مديرُها (محمد أبو خديجة) يَقِفُ صلبًا مُواجِهًا الطلابَ؛ ليتأكدَ من أن الجميعَ يؤدونَ التمارينَ الرياضيةَ بإتقانٍ وجِدِّيةٍ، ويُنشدونَ النشيدَ الصباحيَّ بشموخٍ ورجولةٍ، وخلالَ الحِصصِ كان يتمشَّى في الـممراتِ لا نكادُ نسمعُ سوى صريرِ حذائه.
كنا بُسطاءَ ضُعفاءَ، وكان للمعلمِ هَيبةٌ ورَهبةٌ، وكان للتعليمِ قِيمةٌ، أيَّةَ قيمةٍ.
كانت المتنزهاتُ تَقَعُ على الشارعِ الرئيسيِّ الوحيدِ الواصلِ بين عمّانَ والزرقاءِ (لبنان وإشبيلية وزحلة وسواها) تُثيرُ فُضولَنا، ونحن نرى السياراتِ الفارهةَ تَصطَفُّ أمامَها، يترجَّلُ منها نساءٌ ورجالٌ وأطفالٌ من طبقةٍ نُسميها مُخمليةً، بملابسَ أنيقةٍ وياقاتٍ بيضاءَ، كانت هذه المتنزهاتُ المتميزةُ بأضوائها الملونةِ المتحركةِ، ومكبراتِ الصوتِ التي تَضِجُّ بمغنين، يَشدونَ بأصواتٍ ألِفنا سماعَها في الإذاعةِ، وأحيانًا تستضيفُ مُطربينَ يُحيونَ الحفلاتِ مُباشرةً، مثل: (فؤاد حجازي ودلال شمالي)، فتتطاولُ أعناقُنا، وتتقافزُ نظراتُنا خِلسَةً، لِنراهم مُحاطينَ بحاشيةٍ أنيقةٍ وآلاتٍ لا نعرفُ أسماءها.
كنَّا حينها نعيشُ في حُلمٍ جميلٍ.
سيلُ الرصيفةِ الوقورُ الـمِعطاءُ الجاري معظمَ أيامِ السنةِ، كان مَقصِدَ الزائرينَ من بقاعِ الأردنِّ، يَنشُدونَ في البساتينِ الممتدةِ على جانبيهِ، الراحةَ والـمُتعةَ والابتعادَ عن صخبِ الـمُدنِ، رغمَ أنها لا تُقارَنُ بضجيجِ مُدنِنا هذه الأيامَ.
كنا نأخذُ شباكَنا وسنانيرَ الصيدِ نخوضُ عُبابَ السيلِ باحثينَ عن أسماكٍ نُلقي القبضَ عليها بعدَ عناءٍ، وأحيانًا أخرى نَعبرُ المجرى صُعودًا، لِنصلَ (رأسَ العينِ)، كنَّا نُسميها (الغدنية) لنرى تَدَفُّقَ المياهِ العذبةِ من باطنِ الأرضِ لِتروي ظمأَ مدينةٍ بكاملِ سُكَّانِها ونباتاتِها وحيواناتِها، وكنَّا حينًا نُعرِّجُ على مزرعةِ (أبو إسماعيل الراشد) لِنحظى بِرؤيةِ شجرةِ التوتِ الباسقةِ الـمُعمِّرةِ، نَستظلُّ تحتَ أغصانِها الوارفةِ الظلال، ونعودُ بما تَستطيعُ أيادينا الصغيرةُ أن تحملَه من تُوتِها اللذيذِ.
كلُّ ذلك كان قبلَ أكثرَ من خمسةِ عقودٍ، حينما كان الناسُ من مُختلَفِ الأصولِ والأعراقِ، غنيِّهم وفقيرِهم، مُتساويين في الطيبةِ والأخلاقِ والصفاتِ والسماتِ، وفي أساليبِ المعيشةِ، مُكتنِزينَ بالحبِّ والرضا والقناعةِ، تُجَمِّعُهم البساطةُ الريفيةُ، يتقاسمونَ لُقمةَ العيشِ معًا، حُلوَها ومُرَّها، كانوا يعرفونَ بعضَهم حقَّ المعرفةِ، يتشاركون في أفراحِهم وأتراحِهم. القلوبُ صافيةٌ، والنفوسُ نقيةٌ، والآمالُ واحدةٌ، والهمومُ واحدةٌ، والأبوابُ مَفتوحةٌ على الدوامِ، ونوافذُ الكراهيةِ مُوصَدةٌ بإحكامٍ.
كانت المحبةُ والألفَةُ هي قاسَمًا مُشترَكًا فيما بينهم.
تلك أيامٌ خلَت، كبُرنا بعدَها، وكَبُرت قريتُنا، وتغيَّرت ملامِحُها، وأشدُّ ما يُحزِنُنا أنها ربَّما ما عادَت تَعرفُنا.
ثم انقضت تلك السُّنونُ وأهلُها
فكأنَّها وكأنَّهم أحلامُ
........
أنا الرُّصيفيُّ، يُنبوعُ الهوى بدمي
يروي المُحبِّينَ من بَوحي ومن قَلَمي
هيَ الرصيفةُ ميلادي وقابلتي
وأولُ البوحِ في قُدسيةِ النغَمِ
وهيَ البهيةُ، روضاتي وغانيتي
طِيبُ الأماكنِ يُهدي عاطرَ النَسَمِ
هنا نَثرتُ القوافي في هَوى وَطني
هنا هَتَفتُ بِظلِّ الخافقِ العَلَمِ
إنَّا على العَهدِ، عَقدُ الحُبِّ يَجمَعُنا
يُثري مَشاعِرَنا من طاهِرِ القِيَمِ