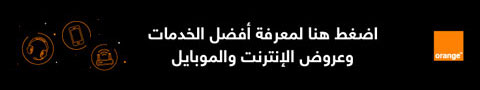امل خضر تكتب : الأردن كلفة الحكمة في إقليم يكافئ الفوضى

نبأ الأردن -
ليس من السهل أن تكون دولة عاقلة في إقليمٍ اعتاد أن يرفع الصوت بدل أن يرفع السقف السياسي. وليس من السهل أكثر أن تدفع ثمن الحكمة بصمت، فيما تُكافأ الفوضى بالاهتمام، ويُمنح التطرّف مساحات أوسع من الإصغاء. هنا، يقف الأردن، لا بوصفه دولة تبحث عن دور، بل دولة تدفع ثمن دورها لأنها اختارت ألا تكون جزءًا من الضجيج.
منذ سنوات، اختار الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أن يتموضع في أكثر المناطق السياسية حساسية منتصف العاصفة. لا انحياز أعمى، ولا خصومة مجانية، ولا خطاب يُدار بالعاطفة. هذا التموضع لم يكن خيارًا مريحًا، بل قرار دولة تدرك أن النجاة في هذا الإقليم لا تكون بالقفز في المجهول، بل بالوقوف بثبات حين يتساقط الآخرون.
الملك، في خطابه السياسي، لا يبيع الوهم، ولا يستثمر في المظلومية، ولا يلوّح بالقضايا الكبرى للمكاسب الآنية. حين يتحدث عن فلسطين والقدس، يفعل ذلك بلغة الوصيّ المسؤول، لا بلغة الخطيب الموسمي. ولهذا، بقي الخطاب الأردني حاضرًا في المحافل الدولية، حتى حين حاول البعض تجاوزه أو تهميشه. فالقضايا الكبرى لا تُحمى بالصراخ، بل بالثبات.
لكن الحقيقة التي لا تُقال كثيرًا، أن الأردن يدفع ثمن هذا النهج يوميًا. يُستدعى عند الأزمات، ويُطلب منه أن يكون جسر عبور، وصوت عقل، وحارس استقرار، ثم يُترك لاحقًا ليواجه وحده تبعات هذا الدور. وهنا، تكمن المفارقة القاسية: كلما كان الأردن أكثر اتزانًا، زادت التوقعات بقدرته على التحمل.
الدبلوماسية الأردنية، التي يُشاد بها في الكواليس، تُدار وفق معادلة دقيقة قول الممكن، لا كل ما يُقال. لكنها اليوم أمام لحظة اختبار تاريخية. فالعالم الذي اعتاد الاعتماد على الأردن كمنطقة توازن، مطالب أخلاقيًا وسياسيًا بأن يعترف بأن الاستقرار ليس موردًا مجانيًا، وأن الدول التي تحمي الاعتدال لا يجب أن تُترك وحيدة.
في الداخل، تتضاعف المسؤولية. فالدولة التي تُحسن إدارة خطابها الخارجي، مطالبة بإدارة خطابها الداخلي بذات الشجاعة. المواطن الأردني اليوم أكثر وعيًا مما يُتصوَّر، وأقل استعدادًا لتقبّل خطاب تقني يُجمّل الأزمات بدل مواجهتها. الصبر ليس مشكلة الأردنيين، لكن غياب الشرح والاتجاه هو المشكلة.
السياسة الداخلية لا يمكن أن تظل أسيرة ردود الأفعال أو لغة البيانات. المطلوب اليوم خطاب سياسي صريح، لا يتهرّب من الاعتراف بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، ولا يختبئ خلف شعارات عامة. فالدولة القوية لا تخشى الحقيقة، بل تخشى الإنكار.
السياسي الأردني أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن يكون امتدادًا حقيقيًا لنهج الدولة المتزن، فيُحسن مخاطبة المواطن كما تُخاطب الدولة العالم، أو أن يتحول إلى عبء إضافي على ثقةٍ تُستنزف ببطء. لأن الهيبة السياسية لا تُبنى بالمناصب، بل بالمصداقية.
الأردن لا يطلب تعاطفًا، ولا يبحث عن مكافآت لفظية. لكنه أيضًا لا يقبل أن يتحول اتزانه إلى نقطة ضعف تُستغل، أو أن يُفسَّر صبره على أنه قابلية دائمة لدفع الكلفة وحده. فالدول، مهما بلغت حكمتها، لا تعيش على النوايا الحسنة فقط.
في زمنٍ تُكافأ فيه الدول التي تُجيد الصراخ، يبقى الأردن حالة استثنائية: دولة تراكم المواقف بدل الشعارات، وتبني الاستقرار بدل المغامرة. لكن السؤال الذي لم يعد ترفًا طرحه
إلى متى تبقى الحكمة عبئًا لا رصيدًا؟
ربما لا يملك الأردن ترف تغيير الجغرافيا، لكنه يملك وضوح الموقف. وهذا، في عالم مرتبك، أخطر من كل الضجيج. لأن الدول التي تعرف ماذا تريد، حتى وهي صامتة، تفرض حضورها في اللحظة التي يفقد فيها الآخرون اتجاههم.