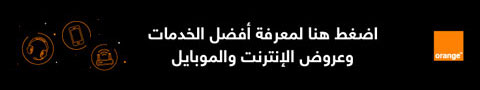د. وليد العريض يكتب: حين خسرت إسرائيل ما لا يحسب بالارقام

نبأ الأردن -
"من ظنّ أن الحديدَ يورثُ الخلود، نسيَ أنّ الظلمَ يورثُ السقوط."
بدايتي : حين تهاوى الوهْم من عَلٍ
كانت تظنّ أن التفوّق في الحديد والنار كافٍ لكتابة التاريخ من طرفٍ واحد، وأنّ "الردع" كفيلٌ بإقناع الأرض بأن تسكت، والسماء بأن تُبرّر. لكنّ غزة الصغيرة تلك المساحة التي حسبوها هامشًا فتحت كتاب الخسارة على مصراعيه، لتقول للعالم: ليست الخسارة دائمًا ما تُقاس بالعدد والعتاد، بل أحيانًا تُقاس بالمعنى وبالذي لم يعد يمكن تبريره.
في هذه الحرب، خسرت إسرائيل ما هو أبعد من الدبابات والموازنات؛ خسرت صورتها وخطابها ونفسها التي كانت تُصدّق أساطيرها.
الخسارة السياسية... سقوط هيبة الحكاية
لم يكن المشهد السياسي سوى مرآة تتصدّع كلما نُظر فيها أكثر. تآكلت صورة الدولة الموحّدة أمام انقسامات الداخل وتحوّلت القيادة إلى فرق متنازعة تتقاذف اللوم.
سقطت حكومة اليمين في مأزقٍ وجودي، ليس فقط أمام العالم، بل أمام شعبٍ اكتشف أنّه يُقاد بغرورٍ أكثر من حكمة.
انفضّ الحلفاء واحدًا تلو الآخر وباتت إسرائيل تواجه واقعًا لم تعهده من قبل: أن يُسائلها من كان يبرّرها وأن يشكّك فيها من كان يُهلّل لها.
الخسارة الاقتصادية.... فاتورة الغرور
ما لم تفعله الحروب السابقة فعلته هذه: فجّرت جيوب الدولة وأغرقت خزينتها في دوّامةٍ من التعويضات والدَّين.
الاقتصاد الذي طالما تباهت به إسرائيل بات مثقوبًا: المستثمرون يرحلون والسندات تتراجع والموانئ تُبطئ شحناتها.
بلغت خسائرها المادية أكثر من 150 مليار دولار لكنّ الرقم، مهما تضخّم، لا يعبّر عن عمق الفجوة النفسية في سوقٍ كانت تُقدّس الأمان كعملةٍ نادرة.
توقّف نموّ الشركات الناشئة وتحوّل وادي السيليكون العبري إلى وادٍ من الشكّ والقلق.
الخسارة العسكرية....
من أسطورة إلى تجربة فاشلة
قيل إن الجيش لا يُقهر، فاختبره الميدان فقهره الواقع.
تبدّدت صورة الجندي الذي لا ينام إلا فوق النصر، بعد أن تحوّلت المعارك إلى كوابيس من الرمال والأنفاق والمفاجآت.
سبعة آلاف قتيل وأكثر وخمسة وعشرون ألف جريحٍ أو معاق وأرتالٌ من المدرّعات التي احترقت تحت غبار غزة.
لم تهزمهم البنادق فقط، بل هزمهم الشعور بأنّهم لا يعرفون لماذا يقاتلون بعد الآن.
الآلة التي طالما افتخرت بـذكائها الاصطناعي فشلت أمام عزيمةٍ بشريةٍ لا تُقاس بالمقاييس التقنية.
الخسارة الاجتماعية والنفسية... تفكّك الداخل
خلف جدران المدن المحصّنة يتكاثر الخوف كفطرٍ في الظلام.
تزايدت حالات القلق، والاكتئاب والانتحار بين الجنود والمدنيين، حتى صار الحديث عن المرض النفسي القومي عنوانًا لمرحلة.
انقسم المجتمع بين يمينٍ متعطّشٍ للدم ويسارٍ يائسٍ من الضمير ووسطٍ يبحث عن معنى البقاء في دولةٍ لم تعد تُقنع نفسها بشرعية ما تفعل.
العائلات المفجوعة تُطالب بالإجابات والأمّهات الثكالى يرفعن صور أبنائهن أمام البرلمان، فيما القيادة منشغلة بتبرير الخسارة كـتكتيكٍ طويل المدى!
الخسارة القِيَمية والأخلاقية حين انكشفت الوجوه
لم يكن سقوط السمعة مجرّد دعايةٍ معاكسة، بل شهادةُ واقعٍ تكلّم بنفسه.
فالمجازر في المستشفيات وقصف المدارس واستهداف الأطباء والصحفيين، كلّها فصول من سجلٍّ لم يعد يمكن مسحه بالبيانات السياسية.
تغيّر وجه إسرائيل في مرآة العالم: لم تعد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، بل باتت المثال الأكمل على كيف يمكن للقوة أن تفسد الأخلاق وللخوف أن يبتلع الضمير.
لقد خسروا التفوق الأخلاقي الذي طالما تفاخروا به وخسروا معه احترام حتى أكثر حلفائهم صمتًا.
الخسارة الدولية...
العالم يعيد حساباته
من عواصم الغرب إلى مقاعد الأمم المتحدة، تغيّر الخطاب.
باتت الصور القادمة من غزة تلاحق صُنّاع القرار في كل مؤتمرٍ وتصويت.
تقلّصت المساحة السياسية للمناورة وصار الدفاع عن إسرائيل عبئًا انتخابيًا في عواصم كبرى.
الجامعات الغربية التي كانت تُدرّس النموذج الإسرائيلي في الأمن والديمقراطية بدأت تسحب محاضراتها وتعيد النظر في مناهجها.
أما الشارع العالمي فقد حسم أمره: من لندن إلى ساو باولو ومن باريس إلى جوهانسبرغ يخرج الناس حاملين صور الأطفال لا الرايات الحزبية.
الخسارة المحلية...
انهيار العقد الاجتماعي
في الداخل، لم تعد الدولة كما كانت.
الاحتجاجات تتّسع والمظاهرات تزداد جرأة والاتهامات بين الحكومة والجيش تملأ الشاشات.
تصدّعت الثقة التي كانت تربط المواطن بمؤسساته وبدأ الحديث الجريء عن الدولة التي لا تعرف نفسها.
المستوطنون خائفون واللاجئون الجدد يؤجّلون هجرتهم والمهاجرون القدامى يتهيأون للعودة المعاكسة.
لم تعد الشعارات تكفي لتوحيد مجتمعٍ بات يتغذّى على التناقضات والخوف.
الخسارة العلمية ومراكز الأبحاث...
سقوط المعرفة الموجّهة
الجامعات التي صمتت طويلاً عن نقد الحرب وجدت نفسها في مواجهة طلابها.
مراكز الأبحاث العسكرية التي بنت شهرتها على التحليل الموضوعي انكشفت كأذرعٍ دعائيةٍ لسياساتٍ فاشلة.
أما العلماء والأطباء والأكاديميون الذين حوصروا أو هاجروا، فتركوا فراغًا معرفيًا لن تملأه سنواتٌ من التجنيد الفكري.
لقد خسروا العقل الذي كان يبرّر القوة، بعدما أثبتت القوة فشلها في كل اختبارٍ أخلاقي أو إنساني.
الخسارة النفسية ما بعد الحرب ليس كما قبلها
ليست الأرقام وحدها التي تصرخ، بل الصمت أيضًا.
في كل بيتٍ جنديٍّ عائدٍ بذاكرةٍ محطّمة وفي كل شارعٍ حكايةُ خوفٍ من الغد.
تلك الدولة التي اعتادت أن تزرع الخوف في الآخرين، باتت تحصده داخل حدودها.
أطفالٌ ينامون على صفّارات الإنذار وشبابٌ يهربون من الخدمة العسكرية وأمّهاتٌ يتهامسن عن ثمن الكبرياء.
لقد تحوّل الأمن تلك الكلمة المقدّسة في الخطاب الصهيوني إلى جرحٍ مفتوحٍ لا دواء له.
الخسارة الوجودية حين تتكلم الوجوه
كل حربٍ تترك وراءها رمادًا، لكن هذه الحرب تركت مرآة.
مرآةً كشفت الوجوه التي ساءها الله، كما في قوله تعالى:
"فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا"
(سورة الإسراء، الآية ٧)
ربما لم تنتهِ الحكاية بعد، لكنّ ملامح النهاية رُسمت بالدم والخذلان.
لقد رأينا "إساءة الوجوه"، ولعلّنا نقترب من لحظة "تتبير العلوّ" كما وعد الحقّ سبحانه.
....
د. وليد العريض
مؤرّخ – أديب – شاعر – كاتب صحفي