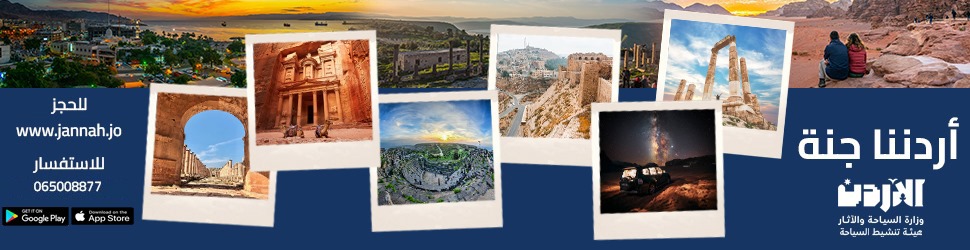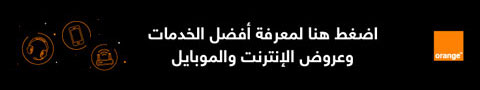د. أحمد فايز العجارمة يكتب : وظيفة الدولة، ونهاية التاريخ !

نبأ الأردن -
إن السؤال عن وظيفة الدولة هو أحد الأسئلة المركزية الكبرى التي صبغت الفلسفة السياسية الحديثة، وقد تباينت إجابات هذا السؤال بتباين الرؤى الفلسفية المختلفة التي نَظًرَت لمفهوم الدولة.
ففي سياق نظرية العقد الإجتماعي، التي استعرضناها في المقالات السابقة، نجد أن وظيفة الدولة هي حفظ الأمن والحقوق الطبيعية للأفراد الذين تنازلوا عن حرياتهم مقابل الحصول على أمنهم وحقوقهم الطبيعية. ولا يجب أن تتعدى وظيفة الدولة أو وظائفها ما يحقق هدف الحفاظ على الأمن والحقوق الطبيعية. ومن هنا جاءت فكرة التدخل المحدود جداً للدولة في شؤون الأفراد والمجتمعات، وهي الفكرة التي تبلورت أكثر ما يكون مع المدرسة الليبرالية التي أتت بمفهوم (الدولة الحارسة Guard State ) التي تكون فيها وظيفة الدولة محدودة جداً، تركز فقط على الأمن والعدل، وتترك الحرية للأفراد في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وقد صبغت هذه النظرة التضييقية لمفهوم الدولة، معظم الفكر السياسي الكلاسيكي الذي تبنى نموذجاً لدولة تقتصر وظيفتها على الحد الأدنى من التدخل في حياة الأفراد والمجتمع (Minimal State). يُطلق عليها أيضًا "الدولة الليبرالية الكلاسيكية" أو "الدولة الحامية"، وهي نقيض للدولة التي تتدخل بكثافة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وهذا هو النموذج الذي تبنته معظم الدول الغربية خصوصاً الولايات المتحدة الأميريكية وبريطانيا.
وعلى النقيض من ذلك اعتبرت الفلسفة الماركسية بان الدولة في المجتمعات الطبقية ما هي إلا آداة للسيطرة بيد الطبقة المهيمنة، فهي انعكاس للعلاقات الطبقية في المجتمع، وهي أداة للسيطرة والقمع تستفيد منها الطبقة المهيمنة اقتصاديًا للحفاظ على نظامه; ولذلك يجب أن تتغير وظيفة الدولة لتصبح آداة لخدمة المجتمع، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال ثورة البروليتاريا او الطبقة العاملة التي تثور لكي يتم انتزاع وسائل الإنتاج من أيدي البرجوازية ونقلها إلى سيطرة الدولة، وهو ما تم تطبيقه في النماذج الإشتراكية للدول التي قامت فيها ثورات أشتراكية تتبنى الفلسفة الماركسية، وهي دول الإتحاد السوفيتي سابقاً والدول التابعة له في المعسكر الشرقي.
وقد انقضى جل القرن الماضي (القرن العشرين)، في صراع بين هذين النموذجين تجلى فيما عرف بالحرب الباردة والتي تشير الى الصراع الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي والعسكري الذي اندلع بعد الحرب العالمية الثانية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وهما القوتان العُظميان في تلك الفترة. وقد استمر هذا الصراع تقريبًا من منتصف الأربعينيات حتى أوائل التسعينيات، وتميز بسباق تسلح، ومواجهات غير مباشرة، وحروب بالوكالة، دون أن يتحول إلى صراع عسكري مباشر بين الطرفين.
وقد انتهت الحرب الباردة بانهيار الإتحاد السوفييتي والمعكسر الإشتراكي، ليعلن المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة نصره المؤزر في هذه الحرب، واعتبار النمموذج الليبرالي للدولة هو النموذج النهائي بل هو نهاية التاريخ التي أعلن عنها الفليسوف الأمريكي فرانسيس فوكوياما في مقاله (كتابه فيما بعد) "نهاية التاريخ والإنسان الأخيرThe End of History and the Last Man " الذي قدم فيه تبريراً مفصلاً لاعتبار النموذج الليبرالي للدولة ذات الوظيفة المحدودة جداً هو النموذج النهائي للدولة ونظامها السياسي، ولا يوجد نظام سياسي آخر يقدم بديلاً أكثر تطورًا أو قابلية للاستدامة على المدى الطويل.
ولكن يالمكر التاريخ، الذي يأبى أن يضع لنفسه نهاية، فما لبث هذا النموذج الليبرالي للدولة محدودة الوظائف أن يعاني من أزمات خانقة هددت النموذج كله بالإنهيار وذلك مع الأزمة المالية العالمية في 2008 أو ما يعرف بأزمة الرهن العقاري. التي أجبرت مفكري الليبرالية المحافظة أن يعيدوا حساباتهم وأن يتراجعوا عن إعلان النصر النهائي لنموذجهم، مما حدى بفوكوياما الى الإعتذار عن مقالة نهاية التاريخ.
وفي الحديث عن هذا الصراع الذي احتدم طويلاً بين هذين النموذجين، قد يتبادر الى ذهن السائل هل من نموذج ثالث يمكن أن يمثل حلاً وسطاً بين النموذجين السابقين؟ والجواب نعم ممكن، وهو ما سيكون عنوان مقالنا القادم حول الديمقراطية الإجتماعية.