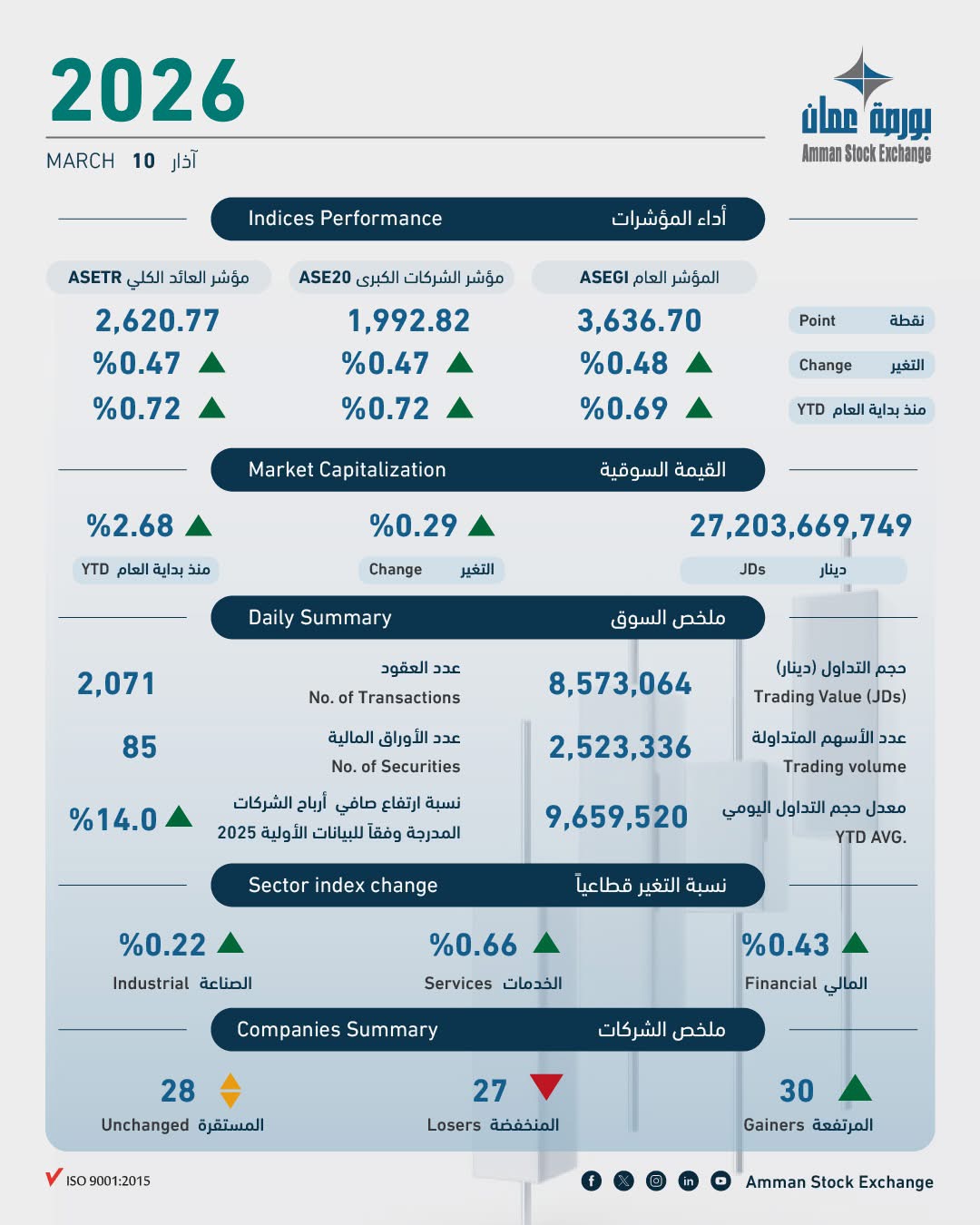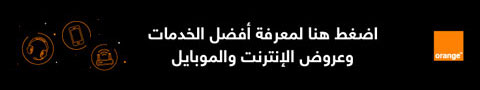عريب الرنتاوي يكتب: طريق الخلاص يبدأ ببعث المنظمة ودمج حماس والجهاد...و"حكومة التكنوقراط" بالتوافق

نبأ الأردن -
هيمنت استقالة حكومة الدكتور محمد اشتية على اهتمامات الفلسطينيين والعواصم ذات الصلة، وقفزت إلى السطح جملة من الأسئلة والتساؤلات، من نوع: ما العلاقة بين استقالة الحكومة والدعوة الأميركية – الغربية – العربية إلى "سلطة متجددة"؟ هل الحكومة هي الجزء المتقادم من هذه السلطة لتُدفَع إلى الاستقالة ولتنطلق من بعد إقالتها، شارة بدء تجديدها؟
ما الذي عناه تداول اسم الدكتور محمد مصطفى لتولي الحكومة الجديدة، هل هي محاولة استباقية لتفادي خيار "التوافق الوطني" عند تشكيل الحكومة، أم أن طرح الاسم سيفتتح بازاراً لمزيد من العروض والأسماء التي تتطاير بكثرة هذه الأيام، في سباق محموم على شكل السلطة والحكومة، وعلى مضمون المنظومة السياسية الفلسطينية بأكملها؟ ما مغزى استقالة اشتية وترويج اسم مصطفى على بعد أيام قليلة عن لقاء موسكو، المفترض به أن يكون محطة مهمة للحوار والمصالحة؟
أياً يكن من أمر، وعلى الرغم من أن الأحادي عن استقالة اشتية وحكومته كانت سابقة للسابع من أكتوبر، فإن أحداً لن يكون في مقدوره أن يتجاهل أن الاستقالة، أو بالأحرى، الإقالة، جاءت استجابة، من نوعٍ ما، لدعوات وضغوط الغرب والعرب بشأن تجديد سلطة شاخت وترهلت وطُعن في نزاهتها ونظافة كفّها.
بيدَ أن المؤكَّد أن ليس هذا هو "التجديد" الذي تتطلع إليه العواصم الداعية إليه، والأرجح أن الشخصية التي ستُحوَّل إليها صلاحيات الرئيس لن تكون أبداً على قياس المرشح الأوفر حظاً، كما بات يطلق عليه، الاقتصادي وموظف البنك الدولي الرفيع، الدكتور محمد مصطفى، وهو الذي يعرف القاصي والداني أنه ما كان ليصبح عابراً للحكومات والمناصب والمواقع، لولا قربه الشديد من عباس، أو بالأحرى، لولا تساوقه واتساقه مع نهج الرئيس وأوامره وتعليماته، وربما ما هو أبعد من ذلك، كما يقول بعض الخبثاء العارفين.
هنا، يصبح سيناريو "قطع الطريق على المصالحة" و"التوافق الوطني" لتشكيل حكومة جديدة هو التفسير الأكثر ترجيحاً لخطوة الإقالة والتسريبات التي تلتها. كما يصبح مرجَّحاً كذلك أن تُعَدّ الإقالة والتسريبات "مسعى استباقياً" للتخفيف من الضغط الدولي – العربي، لتقليص صلاحيات الرئيس وتحويله إلى منصب شرفي/بروتوكولي، أو أقله "بالون اختبار" لا أكثر ولا أقل، فإن الأمر انطلى على الجميع، عاودت السلطة والرئاسة ممارسة يومياتهما المعتادة، وإن تم تنفيسه ورفضه، فسيجري البحث عن خيارات وبدائل أخرى، أحسب أنها متوافرة و"غبّ الطلب".
عواصم عربية أخرى، ومن خلفها دوائر غربية متعددة، لديها تفضيلاتها الأكثر اقتراباً من رؤاها لمرحلة ما بعد الحرب على غزة. وهي تبحث عن أسماء، بأكتاف عريضة، منسجمة عقائدياً مع شعار "لا عباس ولا حماس"، وفي مقدورها أن توفر مظلة سياسية للتجديد المطلوب في السلطة، أمنياً ابتداءً، فالهدف الرئيس، من وراء إطلاق واشنطن شعار "السلطة المتجددة"، هو الوصول إلى منظومة سياسية – أمنية، قادرة على ضبط الضفة الغربية ومنع انزلاقها إلى سيناريو الانفجار الكبير، ونقل التجربة إلى قطاع غزة. وهذا هو الجزء الأكثر أهمية وحساسية في تفويضها، ذلك بأن مهمة "ترويض" القطاع تبدو أكثر استعصاءً من مهمة كبح الضفة. وثمة أسماء يجري تردادها للقيام بهذه المهمة، بل ثمة رزم من الأسماء السياسية والأمنية والاقتصادية التي يجري ترويجها، في السر والعلن أحياناً، نمتنع من الخوض فيها في هذه العجالة.
إجماع، ولكن!
الحقيقة أن البحث في شكل المنظومة السياسية الفلسطينية ومضمونها بعد السابع من أكتوبر، وبعد أن تضع الحرب على غزة أوزارها، لم يتوقف لحظةً واحدة، وانخرطت فيه كل القوى والشخصيات الفلسطينية، وتبلور ما يشبه الإجماع الوطني الفلسطيني، لم تشذّ عنه سوى القيادة المتنفذة في رام الله، على كيفية الخروج من مأزق الانقسام، والتصدي لأعباء ما بعد الحرب وتحدياتها.
الإجماع الوطني الفلسطيني، كما تجلى في ركام المبادرات والمواقف، يلحظ الحاجة إلى البدء بمنظمة التحرير، وبعثها وإحيائها وإعادة هيكلتها، بترتيب انتقالي يتمثل بإنشاء مرجعية عليا موقتة وطارئة للشعب الفلسطيني، تحت ظلال المنظمة وفي إطارها، وتضم مختلف القوى الفلسطينية، وبينها حركتا حماس والجهاد، فضلاً عن شخصيات وطنية داخل الأرض المحتلة وخارجها؛ مرجعية تقوم على الشراكة الفعّالة والحقيقية بدلاً من الهيمنة والاستئثار والتفرد، وتؤمن بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والفاشية والعنصرية والاستيطان، عبر كل الأشكال والصور، وتعمل على مطاردة "إسرائيل" في كل المحافل الإقليمية والدولية، وعبر مختلف الطرائق والوسائل.
وتبلور إجماع ثانٍ أيضاً، على الحاجة إلى تشكيل حكومة من الخبراء والفنيين والتكنوقراط، تُناط بها مهمّات أربع: الإغاثة والإيواء وإدخال المساعدات؛ توحيد مؤسسات السلطة في الضفة والقطاع؛ الشروع في إعادة الإعمار؛ التمهيد لانتخابات عامة، وهي الفيصل والحكم في نهاية المطاف، وهي مصدر الشرعية وطريق تجديدها.
على أن هذه الحكومة يجب أن تتشكل عبر توافق وطني عريض، يوفّر لها المظلة والحماية، ويساعدها على إنجاز تفويضها ومهماتها، وأن تحتكم في مطلق الأحوال لمرجعية وطنية عليا وموحدة، في كل ما يتعلق الأمر بالخيارات السياسية والسيادية الكبرى للشعب الفلسطيني. فمن دون وجود هذه المرجعية، "ستعود ريما إلى عادتها القديمة"، وستتحول أيّ حكومة، وأي رئيس لمجلس الوزراء، إلى "دمية في مسرح العرائس"، تديرها، كيفما أرادت، "ترويكا" متحكمة في زمام المال والسلطة في رام الله.
هذا التصور يبدو مدعوماً من أطراف عربية ودولية وازنة أبضاً، وفي سياقه جاءت الدعوة الروسية إلى اجتماعات موسكو، الخميس المقبل، ولا تمانع أطراف دولية (أوروبية) كذلك في التعاطي معه، إن تم التوافق عليه والعمل به، ما دامت هذه الأطراف ستكون ملزَمة بالتعامل مع مؤسسات حكومية رسمية فلسطينية، وليس مع هذا الفصيل أو ذاك. ومعظم فصائلنا للأسف، إن لم نقل جميعها، مصنَّف "إرهابياً" في كثير من العواصم الغربية، وحتى العربية.
ولنا في التجربة اللبنانية ما يشجع على الاعتقاد أن ترتيباً كهذا يمكن أن يبتلعه المجتمع الدولي، وإن مع قليل من الماء. فكل عواصم الغرب تتعامل مع الحكومة والبرلمان اللبنانيين، مع أن حزب الله المصنَّف "إرهابياً" حاضر بوزرائه في الحكومة، وبنوابه في البرلمان. والأطراف الغربية والعربية، النشطة في ملفي الرئاسة ووقف النار في جنوبي لبنان، وقبلها "ملف ترسيم الحدود البحرية"، تدرك أنها تتفاوض مع حزب الله، حتى إن لم تلتقِ قياداته مباشرة، في حين أن بعضها لا يمانع لقاء قيادات سياسية، وحتى أمنية، من الصفوف الأولى في الحزب.
الفارق بين التجربتين اللبنانية والفلسطينية أن الأفرقاء اللبنانيين، بمن فيهم خصوم الحزب، ومؤسسات الدولة المتعددة، من الرئاسات الثلاث، حتى المؤسسات العسكرية والأمنية، يعترفون بوجود الحزب مكوناً أصيلاً من مكونات المجتمع اللبناني، لا يمكن تجاوزه، ويتقبلون، على رغم الخلافات والاختلافات السياسية، فكرة وجوده في المؤسسات وفي المعادلة اللبنانية، ويقبل بعضهم طائعاً وبعضهم الآخر مرغماً، في حين أن "المعادلة الصفرية" ما زالت تتحكم في نظرة رام الله إلى حماس، وترى فيها مشروعاً بديلاً، وليس مشروعاً شريكاً.
وهي، بخلاف الأطراف اللبنانية المطمئنة إلى سلامة حصتها في النظام السياسي لأسباب طائفية ومذهبية، واستولدت قاعدة المناصفة ومعادلة "6 و6 مكرر"، تخشى على دورها المهيمن ونفوذها المتفرد بالمؤسسات وآلية صنع السياسة والقرار في السلطة والمنظمة.
الرئاسة الفلسطينية لم تُبد، حتى الآن، حماسة لدمج حماس في منظمة التحرير، وهي قابلت الدعوات الفلسطينية والعربية، التي تلقتها بهذا الصدد، بمواقف حذرة وغامضة، بعضها يتذرع بالخشية من ردود أفعال إسرائيلية (أموال المقاصة) وعربية (المعسكر المناهض للإسلام السياسي)، أو غربية، وتارة أخرى، بذريعة أن حماس لم تستجب لشروط الرباعية الدولية، القائمة على الاعتراف بـ"حق إسرائيل في الوجود" ونبذ الكفاح المسلح وقبول التزامات "أوسلو".
ربما لا يبوح الناطقون باسم الرئاسة، والمحيطون بها، بتفاصيل هذه الاشتراطات المخجلة والمذلّة، ويفضلون إعادة صياغتها بعبارات أخرى، من نوع "قبول برنامج المنظمة والتزاماتها"، هكذا بالعموم. والحقيقة أن مؤسسات المنظمة، منذ عدة أعوام، قررت كذلك الانسحاب من "أوسلو" وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل" ووقف التنسيق الأمني معها، على نحو يقرّب المنظمة من حماس، وليس العكس، وأن من يخرق قرارات المنظمة وتوجهات مجلسيها الوطني والمركزي الأخيرة، هي قيادة المنظمة وليس أحداً غيرها. فعن أيّ مقررات والتزامات تتحدثون؟!
في أي حال، لم تكن منظمة التحرير الفلسطينية، يوماً، إلا إطاراً جبهوياً موحداً للطاقات والفصائل الفلسطينية، من دون أن يشترط على أي منها التخلي عن طروحاته وبرامجه ورؤاه السياسية والأيديولوجية.
فلماذا تصر قيادتها الحالية على إخضاع الجميع لمقاساتها، القصيرة والمحدودة، في أيّ حال؟ ولماذا الإصرار على دفع الجميع إلى الالتحاق بخياراتها على رغم أن الوقائع العنيدة، وبالذات في الحرب البربرية على غزة، أظهرت بؤسها وتهافتها؟!
ولا يتردّد بعض الناطقين باسم الرئاسة، أو المتطوعون للنطق باسمها، عن إظهار نوع من الغطرسة والاستعلاء اللذين لا يليقان بهم، وهم الذين يكادون لا يغادرون منازلهم إلى مكاتبهم من دون "تنسيق" مسبّق مع الاحتلال، فتارة يخرج علينا من يطالب حماس بممارسة "النقد الذاتي" بشأن "انقلابها" وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 2007، وتارة أخرى، بوضعها على قدم المساواة، مع أنصاف وأرباع الفصائل التي تدور في فلك رام الله، عبر عرضهم مقعداً واحداً لها وآخر للجهاد، وكان الله بالسر عليماً.
هذه الألاعيب لن تُجْدي نفعاً، ولن تُخفي الحقائق التي بات يعرفها القاصي والداني، بمن فيهم خصوم المقاومة وألد أعدائها. ومن لا تقنعه أرقام استطلاعات الرأي العام، فعليه أن يجرؤ على النزول إلى الشارع لقياس شعبيته وشعبيته رؤسائه ومرؤوسيه. ومن لفظ المصلون إمامته لهم في صلاة الجمعة، فعليه أن يَرْعَوي وأن يتواضع قليلاً، وأن يكفّ عن إطلاق المواقف المخجلة، باسم رؤسائه وأولياء نعمته.
والخلاصة، أن ليس ثمة طريق للخروج من مأزق الانقسام، وقطع دابر المؤامرة الإسرائيلية – لجهة فصل غزة عن الضفة، و"لا فتحستان ولا حماسستان"؛ ليس ثمة وسيلة لقطع الطريق على المشروع الأميركي (لا عباس ولا حماس)، والذي ردد صداه بعض الطامحين المستعجلين لوراثة كل من غزة ورام الله، سواء بسواء، إلّا عبر سلوك الطريق الفعلي المفضي إلى تعزيز صمود الفلسطينيين وتصليب منعتهم، واستنقاذ مشروعهم الوطني؛ طريق منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد، بعد إعادة هيكلتها وبناء المرجعية الوطنية العليا، والمفضي إلى حكومة توافق من فنيين وخبراء واختصاصيين، من ذوي الأكف والسرائر النظيفة، من أجل تصفية آثار العدوان على غزة، واستنهاض الشعب على الطريق الطويل للحرية والاستقلال.