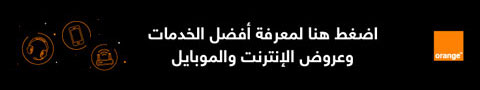عريب الرنتاوي يكتب: لماذا ينجح اليسار في أميركا اللاتينية ويفشل في العالم العربي؟

لم أكن أحمل وأنا أدلف عتبات القارة اللاتينية لأول مرة في حياتي، ومن بوابة ساو باولو، سوى سؤالٍ واحدٍ: لماذا ينجح اليسار في أميركا اللاتينية ويفشل في العالم العربي؟...كانت البرازيل تقف على عتبة مفترق فاصل بين يمين شعوبي متطرف يقوده جايير بولسونارو ويسار متجذر معتدل يقوده لولا دا سيلفا، الحملات الانتخابية محتدمة، والاصطفافات لا تخفى على الناظرين: فقراء توسعت جيوبهم وأحياء الصفيح التي تضم الملايين منهم، يدعمون دا سيلفا، و"أوليجارشية" صلفة ومتوحشة، لم تجد أفضل من "ترامب البرازيل" لتمثيلها بولاية ثانية: بولسونارو.
بالطبع، كانت لدي دوافع شخصية خاصة، خارج السياق اللاتيني، تجعلني مشدود الأعصاب، سيما عندما ذهب الرجلان إلى جولة إعادة ثانية، في سباق الـ "كتفاً لكتف"، وبفارق يقل عن الواحد بالمئة لصالح "مرشحي المفضل"، دا سيلفا...فعلاوة على الأداء المتغطرس للرئيس اليميني الشعوبي، زمن كورونا وما بعدها، كانت مواقفه الداعمة بلا تحفظ لإسرائيل، وتوجهه لنقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس، سيراً على خطى "قدوته" و"مُلهِمه" دونالد ترامب، كافية لتخليق إحساس عميق لدي، بأنها "معركتي"، وليست معركة فقراء البرازيل وحدهم.
في بوينس إيرس، توسعت حدود الفرصة المتاحة لي للتعلم، فهناك، وعلى هامش ورشة عمل ممتدة من تنظيم "RESDAL"، أتيحت لي فرصة الالتقاء بنشطاء وسياسيين وخبراء من الأرجنتين وكل من الأورغواي وكولومبيا والإكوادور والمكسيك وغيرها من دول القارة الجنوبية، فأخذت بطرح السؤال/الهاجس على كل من ألتقيه، أو بالأحرى شقه الأول المتعلق بنجاح اليسار اللاتيني، فمهمة تفسير إخفاق اليسار العربي، تقع على كاهلي ومن يشبهونني في منطقتنا، وهي بالقطع ليست مهمة الرفاق هناك.
سألت الجمع عن الحركات التي كنا نتابعها ونقرأ عنها: توباماروس، فرابندو مارتي، فارك، وغيرها...هؤلاء غادروا "الأدغال" وتخلوا عن السلاح، ومعظمهم يرتدي اليوم، البدلات وربطات العنق، ويتولون في عواصم بلادهم، مواقع مسؤولة...لقد فعلوا ذلك بنتيجة قناعات وتسويات، وبعد أن انفتحت آفاق المشاركة السياسية والتداول على السلطة، وحين وصلوا وخصومهم إلى قناعة مشتركة، مفادها أن طريق التغيير لا يمر بالضرورة عبر فوهة البندقية، وأن كلفة التخلي عن الشعارات "الأقصوية" أقل بكثير من كلفة المضي في قتل الإنسان وتدمير البنيان.
أميركا اللاتينية كانت ودعت القرن العشرين بثورة شافيز- البوليفارية في فنزويلا (1998)، حكومة دا سيلفا الأولى في البرازيل (2002)، وفي العام 2003، سيتولى رئاسة الأرجنتين اليساري نستور كيرشنر، وبعده بعامين، سيصبح إيفو موراليس رئيساً لبوليفيا، وسيعود دانيال أورتيغا إلى الحكم من جديد في نيكاراغوا، وفي العام 2008 سيصل اليسار بزعامة خوسيه مودجيكا إلى حكم الأوراغوي، وسيستمر الحال على هذا المنوال حتى منتصف العقد الفائت: مادورو يرث شافيز في فنزويلا بعد رحيله (2013)، وديلما روسيف الخارجة من عباءة دا سليفا تتولى حكم البرازيل في العام 2010.
يحدثونك في بوينس أيرس عن نظرية "البندول"، في إشارة لتعاقب اليسار واليمين على الحكم في دول القارة، لقد انحسر نفوذ اليسار في المنقلب الثاني من العقد الفائت، إثر انحسار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت القارة بقسوة، ثمة علاقة طردية بين صعود اليسار وتفاقم الضائقة الاقتصادية – الاجتماعية، اتساع جيوب الفقر والمناطق والفئات المهمشة، يعطي اليسار زخماً شعبياً، كفيل بإعادته للسلطة (يحدث هذا في كل دول العالم تقريباً ما عدا منطقتنا العربية)، لكن جائحة كورونا، بعواقبها الوخيمة الممتدة والمتشعبة، ستسرّع عجلة "البندول"، الذي سيعاود قذف السلطة مجدداً في أحضان اليسار، وقبل أن يكتمل عقد التحولات اليمينية في القارة، وربما ستضيف أزمات المناخ وحرائقها المشتعلة بعداً إضافياً للجدل الدائر في عموم القارة، كما أن الحرب في أوكرانيا وعليها، ستفاقم أزمات الطاقة والغذاء وترفع من أسعارهما بشكل جنوني.
سيقود جوستافو بيترو اليسار في كولومبيا لأول مرة إلى النصر في انتخابات 2022، وسيعود دا سيلفاً ثانيةً، زعيماً متوجاً للبرازيل، برغم سنوات السجن والمحاكمة والتهم الملفقة، وفي تشيلي سيتفوق جابرييل بوريك على خصومه اليمينيين في انتخابات 2022، وقبلها بعام، كان اليسار قد استوطن في بوليفيا بزعامة لويس آرس، وانتصر في البيرو بزعامة بيدرو كاستيلو، وسيغطي اللون "الوردي" المتدرج، معظم خريطة دول القارة، وصولاً إلى أميركا الوسطى والكاريبي.
اليسار اللاتيني ليس من القماشة ذاتها، فثمة "تدرج لوني" يأخذك من "الأحمر" إلى "الوردي"، اليسار الشمولي – السلطوي، في طبعاته القديمة، يكاد يتمركز في كوبا وفنزويلا، وبدرجة ما في نيكاراغوا، فشل واشنطن في الإطاحة بالنظامين الكوبي والفنزويلي، رغم المحاولات المتكررة، وفّر فسحة من الزمن لليسار في بقية بلدان القارة، لإجراء المراجعات واستدخال التحديثات في لغته وخطابه وأدوات عمله، وثمة تعاطف لاتيني عموماً، مع شعوب البلدين المحاصرين بالعقوبات ومحاولات التدخل الأمريكية التي اعترف جون بولتون بآخرها: تدبير محاولة انقلاب ضد مادورو في فنزويلا، وضلوعه شخصياً فيها حين كان إلى مستشاراً لترامب، بيد أن هذا التعاطف لا يقلل من حجم الفجوة بين هاتين المدرستين اليساريتين: الحمراء والوردية.
اليسار اللاتيني عموماً، ليس من القماشة التي خاط خيوطها الأخوين كاسترو وهوغو شافيز، فهو يسار ديمقراطي، يؤمن بالتعددية وتداول السلطة والمجتمع المدني وحرية الصحافة والإعلام، وهو ينافح من أجل استقلال دول القارة عن واشنطن وتنويع علاقاتها الدولية وأسواقها الخارجية، من دون "عداء مفرط للإمبريالية بالضرورة"، وهو يولي اهتماماً كبيراً بقضايا التغير المناخي وحقوق الانسان والنسوية وحقوق المثليين، ويتكيف وفقاً لمقتضيات السياق الاقتصادي – الاجتماعي – الثقافي – التاريخي لبلدان القارة، وتختلف أولوياته باختلاف دوله ومجتمعاته، وما يعتمل فيها من أدوار للكنيسة المحافظة من جهة والمجتمع المدني والحركات النسائية والشبابية من جهة ثانية، وهو في معظمه، يسار شبابي، قادر على إدماج الشباب وإفساح المجال لمبادراتهم ويتحدث بلغتهم، ويستخدم أدواتهم. ففي تشيلي، حيث للمجتمع المدني مكانة مرموقة في البلاد، يتبني الزعيم اليسار الشاب جابرييل بوريك سياسات بيئية وجندرية ويدافع عن حقوق المثليين ويطلب المساواة بين الجنسين. في حين يَظهر خوسيه كاستيلو في بيرو كزعيم محافظٍ معارض بشدة لسياسة الإجهاض الاختياري وزواج المثليين، وثمة ما تجدر ملاحظته كذلك، من فوارق بين يسار الأرجنتين الأكثر تأثراً بأجندة المجتمع المدني، ويسار البرازيل الأكثر عرضة لتأثيرات الكنيسة المحافظ، أي باختصار، فإن هذا اليسار هو ابن بيئته، يتكيف معها ويسعى في تغييرهابالطرق السلمية التدريجية الديمقراطية، بعد أن ودّع حقبة الثورات والانقلابات، وهو في الغالب الأعم، يراوح ما بين مدرسة الاشتراكية الديمقراطية ومدرسة الديمقراطية الاجتماعية، وينتمي في معظمه، إلى "يسار الوسط".
"البندول" في أميركا اللاتينية يتحرك يساراً وبصورة قد تستغرق العقد الثالث من القرن العشرين، لكن أحداً، لا من اليمين ولا من اليسار، لديه الثقة بأن حكومات اليسار ستستمر في مواقعها إلى "يوم الدين"، الجميع يشترك في القناعة بالتداول، وحكومات اليسار عرضة للفحص والتقييم والتقويم، وصناديق الاقتراع لها بالمرصاد، ومن غير المتوقع أن تظل في السلطة، مُعطّلةً حركة "البندول"، وقد ينتهي هذا العقد، بموجة يمينية في الدول الملونة بـ "الوردي"، أو بعضها على الأقل، تلكم هي سنة الحياة في التزاحم والتداول.
أين اليسار العربي من كل هذا؟
يعيش اليسار العربي عموماً، أزمة مركبة، ثلاثية الأبعاد: (1) أنظمة الاستبداد العسكرية والسلالية، التي سدّت أفق التعدد والتزاحم السلمي والتداول... (2) حركات دينية متجذرة شعبياً، في مضمونها ليست ديمقراطية، بل ومعادية لها... (3) مأزق ذاتي، ناجم عن جمود عقائدي من جهة وفقدان الهوية والبوصلة من جهة ثانية...ولقد تضافرت جملة هذه العوامل، في تشكيل "أزمة بنيوية" حادة، يرزح اليسار، ومن خلفه مجتمعاتنا ودولنا، تحت نيرها الثقيل.
في البعد الأول؛ ثمة انسداد في مسارات الإصلاح والحوكمة الرشيدة، في بلداننا، ثمة استعصاء ديمقراطي عميق ومتجذر في مجتمعاتنا، ثمة ضيق بالآخر والتعدد والتنوع، عشرية الربيع العربي، ألقت حجراً ضخماً في مياه الركود والاستنقاع الآسنة، وهزّت الثالوث غير المقدس: "التمديد والتجديد والتوريث"، بيد أنها لم تحمل في طياتها بذور تغيير حقيقي، حتى في الدول التي نجحت فيها الثورات والانتفاضات في "تغيير النظام" وليس "تغيير سياساته" فحسب.
يولّد وضع كهذا، شهية أقل، للتكيف وتجديد الخطاب وصياغة البرامج، ويضعف الإقبال على المزاحمة والمنافسة، طالما أن وظيفة الانتخابات هي تجميل الصورة القبيحة لأنظمة الحكم، وليس تجديد الطبقة السياسية وتغيير النهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وطالما أن "شرف صناديق الاقتراع" قد انتهك عشرات المرات، وليس مرة واحدة...هذا عامل، يتعين أخذه بنظر الاعتبار ونحن نتحدث عن "أزمة اليسار العربي".
في البعد الثاني؛ ولأسباب لا مجال لذكرها في هذه المقالة، توفرت عوامل داخلية وخارجية، زمن الحرب الباردة وما بعدها، لتفتيح كل الأبواب أمام موجات المد المتلاحقة للإسلام السياسي (الإخواني) والاجتماعي (بطبعاته السلفية)، تارة لمواجهة المد الشيوعي وأخرى لاحتواء المد الشيعي، وانتهينا إلى وجود لاعب كبير في مجتمعاتنا، وضع كل ثقله خلف الأنظمة والحكومات وداعميها الدوليين، لشيطنة اليسار و"تكفير" العلمانيين، ومحاصرتهم وتقطيع السبل من أمامهم.
لا وجود لحركات سياسية – دينية فاعلة في أمريكا اللاتينية، وتأثيرها يكاد يقتصر على البعد الاجتماعي المتعلق بالقيم والأخلاق والأسرة وغيرها...وفي مرحلة التحرر من الاستعمار، لعبت بعض المدارس الكنيسة دوراً بارزاً في مقاومة الاحتلالات الغربية (لاهوت التحرير)، في حين تولت حركات قومية – يسارية – علمانية بالأساس، قيادة شعوبنا في مرحلة "تصفية الاستعمار"، وبناء دول ما بعد الاستقلالات...فشل هذه الحقبة في بناء "دولة الأمة"، وعودة الاستعمار بأشكال مضمرة وغطاءات جديدة، ألقت بتبعاتها على مختلف مدارس اليسار العربي.
في البعد الثالث؛ في حربه على جبهتي "الطغاة" و"الغلاة"، أخفق اليسار في تطوير خطابه وممارساته وتجديد أدواته، ظل أسيراً لخطاب إيديولوجي "محنط"، ولأساليب تنظيمية "ستالينية" في جوهرها، لم يواكب متغيرات العصر، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ودول المنظومة، ووقع بعضه في هاوية سوء التقدير وفقدان البوصلة واضطراب الأولويات...ففي مواجهة "الطغاة"، لم يجد البعض غضاضة في الانضواء تحت لواء "الغلاة"، وتدثر بعباءة تنظيميات وحركات وفصائل إسلاموية، وشجعه على ذلك تبني هذه الحركات لخطاب "مقاوم" لإسرائيل أو للغرب الإمبريالي.
وفي سعيه للفكاك من القبضة الصلبة لهذه الحركات على الشوارع العربية، لم تتورع فصائل منه، عن تقديم فروض الولاء والطاعة، لأنظمة ديكتاتورية وقمعية، تحت شعارات زائفة من نوع "الدفاع عن الدولة" والحيلولة دون سقوطها...سنوات التيه التي عاشها اليسار منذ هزيمة الاتحاد السوفياتي في المباراة مع الغرب، عمّقتها عشرية الربيع العربي، التي كشفت عن هشاشة البنية والخطاب وتخلف الممارسة وجمود التنظيم لدى العديد من الأحزاب اليسارية العربية، ولهذا بات مألوفاً أن يطلق عليها اسم "أحزاب الكسور العشرية" في إشارة لحصادها المتواضع في الانتخابات العامة.
اليسار، "الوردي" بخاصة، نجح في أمريكيا، بوصفه يساراً ديمقراطياً اجتماعياً، يتوخى العدالة الاجتماعية وانتشال الفئات والطبقات المهمّشة من براثن الفقر والجوع والبطالة، في إطار من العمل الديمقراطي – التعددي، ومن ضمن مراجعة شاملة للبرامج والأولويات والمرجعيات، وثورة على أدوات العمل والتنظيم ولغة التخاطب مع النساء والشباب، وهي مهمة لم يشرع اليسار العربي بعد، في تجشّم عنائها، ولذلك نجح اليسار اللاتيني وفشل اليسار العربي.