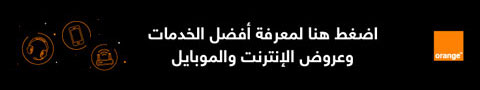د. ذوقان عبيدات يكتب: الإصلاح التربوي: التحديات والحلول

من أصعب التحدّيات في أي مجال هو البحث عن حلول، والتحدّي الثاني قبول الحلول، والتحدّي الثالث تجريب الحلول وتطبيقها! ولنبدأ بالتحدّيات في مرحلة ما قبل الحلول.
(1)- التحدّيات التربوية:
هناك تحدّيات كثيرة معروفة للجميع، وأُعلنت عشرات المرات مثل: غياب الرؤية، والفردية المزاجية، وسهولة الحديث عن التطوير، وغياب المعرفة العميقة بالنظريات التربوية، وضعف الإدارة العامة والتربوية. هذا كله معروف، وسيتكرر مع كل تغيير وزاري أو شبه وزاري، والدولة كعادتها تنقذ وزراءها ومسؤوليها حين تلجأ لتغييرهم بعد فترة قصيرة؛ وبذلك، تمد لهم حبل نجاة!!
فكل وزير يقول: كنت سأفتح القسطنطينية لو أعطوني فرصة أطول. فهناك من يدعي أنه كان سيطور الامتحانات العامة والتوجيهي، بل الكل ادّعى وصلًا بليلى!. وهناك من ادّعى أنه طوّر المناهج والتدريب والإشراف.. إلخ. مع أنّ أحدًا ما لم يرَ مثل هذه “التطويرات”! وستبقى الأمور جدلية ما دامت المساءلة غير موجودة! وهذا حبل نجاةٍ آخر تمدّه الدولة لإنقاذ ضعف وزرائها وأمنائها ومديريها العامين والخاصين، وسيبقى الأمر كذلك ما دامت الدولة كذلك!
لن أتحدث عن أسلوب “الفزعة”، “وين النشامى” و”توخِّي” الخيرب من يحضرهم المسؤول الكبير من أصدقائه. وبالمناسبة رئيس القسم يختار العاملين معه ممن يتوخّى فيهم الخير من أصدقائه! وهكذا، في استمرار مدِّ حبل النجاة فإن الوضع سيستمر! طبعًا، الحديث عن خيارات الدولة في التدوير واختيار الضعفاء لن يغيّر من الأمر شيئًا!!
(2) الحلول الجاهزة:
ما إن يأتي مسؤول – وغالبًا ممن لا يمتلكون رؤية مسبقة – حتى يفاجىء المجتمع بخطة شاملة – وأرجو أن لا يعتقد أحد بالذات أنه مقصود – لأن كل مسؤول شبابي أو ثقافي أو تربوي أو سياسي – وليس لدينا سياسيون- يتصرف هكذا، ويعلن خططًا وهمية شاملة لتطوير قطاعه، ولا يعرف أحدٌ مصدرها، فهو لا يمتلك رؤية فردية ولا حزبية ولا يتبنى مدرسةً ما، فيفاجئنا بخطة!، يلغي فيها إجراءً سابقًا لغيره، أو يفرض فيها موّالًا شخصيّا جديدًا دون أن يقدم لنا معطيات مقنعة، وأعطي مثالًا عشوائيًا: التفكير بإلغاء الدراسة الجامعية الموازي! إن مسوّغات وجودها وإبقائها واضحة جدّا:
توفّر دخلًا ماليّا تحتاجه الجامعات.
توفر فرَصًا لطلبة مقهورين من نظام فشل في إعطائهم فرصًا لدراسة ما يرغبون فيه – وهذا حق من حقوق الإنسان – لا جدال فيه. فما الداعي للتفكير في إلغائه؟
هل تم التحقق من أنّ خريجي الموازي أقل قدرة من زملائهم على الاستيعاب؟ أو يعانون من نسب نجاح جامعي أو مهني ضعيف؟ هل طبيب الموازي أقل قدرة من الطبيب البصّيم الذي تفوّق عليه بعلامة، أو بجزء مئوي من علامة! ما نسبة الأطباء الفاشلين بالمُوازي؛ قياسًا لزملائهم غير المُوازين؟
إذا كان لدينا مثل هذا، فإن هذا يدين من خرّجهم ضعافًا، وأن الحل دعمهم وتعليمهم بشكل أفضل، والتأكد من امتلاكهم للمهارات المطلوبة قبل تخريجهم وليس إلغاء الموازي!!
إذن: المطلوب قرارات؛ بناءً على معرفة دقيقة واضحة! إن مشكلتنا هي إحضار حلول جاهزة وليست ناتجة عن رؤية أو معلومات أو مقترحات بحثية. لا أدري ما الذي يمنع وزيرًا من تشكيل فريق وطني من مفكرين، أو أصحاب خبرة يقدمون له أفكارًا أكثر موضوعية وموثوقية من أفكاره المزاجية أو أفكار شلّته وأصدقائه؟
(3)- كيف نبدأ الإصلاح التربوي؟
أعدّ معهد “كارنيجي” دراسة حول أسباب فشل محاولات الإصلاح التربوي في عدد من الأقطار العربية منها الأردن، لخّص فريق الدراسة برئاسة مروان المعشر عوامل الفشل، بأنها:
الفوقية والعلاقات الهرمية، وصدور أفكار الإصلاح من السلطة لا من الميدان بمعلميه ومدارسه.
الإصلاحات الجزئية دون وجود رؤية شاملة تتناول أبعاد العملية التربوية بتزامن وتكامل.
علاقات القوة والسلطة والثقافة السلطوية والاستعلائية التي تسود المؤسسات التربوية الرسمية.
تهميش التفكير الناقد والإبداع.
وهذا يعني أن أفكار الإصلاح تفتقر إلى الإطار الفكري لا مجرد أدوات التنفيذ.
ويتوصل من يستنتج من الدراسة أن عمليات الإصلاح التربوي تاهت في تقديم أدوات مبعثرة، فتارة يتحدثون عن إصلاح التوجيهي، وتارة عن تقويم الطلبة، وتارة عن الفاقد التعليمي، أو الفجوات التعليمية، وتارة عن المناهج دون أي روابط بينها.
فالتعليم كما يراه “إيريك جايمسون” ملخصّا آراء عشرات الخبراء: إن مسيرة التعليم تميزت بامتحانات جافة في منهاج ضيق الأفق، مع التركز على ثغرات، ووضع ضوابط مشددّة وأطر بالية، ونظم تفتيش صارمة، مع تجنّب شديد للمخاطر، أدى كل هذا إلى إنتاج طلبة لا يفكرون، ومعلمين سلطويّين، وثقافة فوقية، وإدارات مهلهلة وقيادات بائسة، ويخلص الخبير إلى القول:
إن إصلاح التعليم عملية سياسية وليست تقنية! والفكرة الجديدة هي أن النظام التعليمي الخاضع كليّا إلى المجتمع لن ينتج مواطنين مبدعين ما لم يسمح للتنويريّين في المجتمع بقيادة التعليم!!
وفي الأردن يتحدث تقرير المعشّر- كارنيجي – أن من أسباب فشل الإصلاح في الأردن: نقص الموارد المالية، وهجرة القيادات التعليمية الكفؤة إلى الخليج، لكن العامل الرئيس هو غياب القيادة المتماسكة والواعية، إضافة لسبب مهم جدّا وهو” معلوماتية السيطرة” التي حوّلت الطلبة إلى متلقين سلبيّين! طالما افتخر مسؤولون أردنيون بأن أسئلة الامتحان كلها من الكتاب! وقد نشرت جريدة “الغد” تصريحًا لوزير التربية والتعليم في 28/12 أن جميع أسئلة امتحان الدين جاءت من الكتاب.
ويذكر تقرير “كارينجي” أن أبرز الإصلاحات التعليمية تمثّل بإنشاء المركز الوطني للمناهج؛ لكي يعمل بعيدًا عن تأثيرات الثقافة المجتمعية! وكان ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح! طبعًا لم يدرك واضعو التقرير أن المركز يخضع كليّا لرقابة المفتي ووزير الأوقاف، حيث تم رفض الحديث عن نظرية النشوء والارتقاء – دارون – التي تدرّس في كل العالم عدا الأردن!.
ويمكنني تلخيص أبرز تحدّيات تطوير المناهج في الأردن هي:
تغييب الخبراء الحقيقيّين، وسيطرة الفكر التربوي التقليدي الموالي للفكر المحافظ، ربما بدرجة تفوق ما كان عليه في وزارة التربية، ففي المجلس التنفيذي، والإدارة والمجلس الأعلى للمناهج، ومجلس التربية سيطرة كلية للفكر المحافظ! ومختطفو المجتمع الأردني مستعدون لإثارة المجتمع على أي كلمة مثل: الشك، والاقتصاد في اليقين، والمرأة والأسرة وحقوق الطفل ورواية عادية، ومحاربة التلقين، وحتى التفكير!!!
(4)- ما المطلوب عمله؟
إن الإصلاح التربوي لا يمكن أن يتم دون إصلاح سياسي، واجتماعي، وثقافي، وحتى اقتصادي! وهنا تثور أسئلة تقليدية ضرورية قبل البدء بأي إصلاح:
1- هل تتوافر إرادة إصلاح عُليا؟ وإذا توافرت ما مدى قدرتها على توفير أفكار الإصلاح وقادته وبيئته؟
2- هل يمكن لقادة الإصلاح أن ينقادوا لقيم المجتمع، ولمختطفي المجتمع من متطرفين، وحتى مشاريع إرهاب؟ أم أن مسؤوليتهم تكمن في محاربة التطرّف والإرهاب؟ وإذا حارب الإصلاحيّون التطرف مَنْ سيقف معهم؟ هل الدولة راغبة في فتح هذا الملف؟
3- إن إصلاح أي قطاع لا يتوقف على العاملين فيه! فلماذا تختار الدولة تقنيّين لإحداث التطوير؟ وعليّ أن أكرر أن سياسيين مثل مضر بدران، عبد السلام المجالي، وعبد الرؤوف الروابدة، حتى ذنيبات، كانوا الأكثر تأثيرًا في التعليم.
4- هل أن خيارات الدولة لقيادات الإصلاح هي الخيارات المناسبة؟ أم أنها تتعمد اختيار زبائنها من المؤلفة قلوبهم؟
تقودنا هذه الأسئلة إلى مجموعة من الخطوات:
الأولى؛ يبدأ الإصلاح في ثقافة السلطة والدولة، فالإصلاح لا يبدأ في المدرسة، بل “يُرسل إلى المدرسة “فالمدرسة هي أداة الدولة وأداة المجتمع، ولذلك تحدد الدولة رؤية الإصلاح العام والإصلاح التعليمي.
الثانية؛ تقوم الدولة بإقناع المجتمع بهذه الرؤية التي تقود إلى تطوير ثقافة المجتمع وقيمه، والتي قد لا تنسجم كلها مع القيم المحافظة، والسائدة التي كبّلت المجتمع، ولكي لا نعطي الفرصة لأي قنَص أو قنّاص، فالمقصود بالقيم المطلوبة هي:
الحرية والتفكير الناقد، وحق النقد الفكري لجوانب من الثقافة، وعدم التسليم بما هو شائع لمجرد شيوعه، وإلغاء الوصاية على الفكر والفن والأدب، والطفل، والمدرسة، والحزب والرياضة وغيرها. وتقديم بدائل، وخيارات، وعدم التضييق على أي مفكر.
والثالثة؛ هي إقناع المعلمين بأنهم مسؤولون عن طرح خيارات وبدائل، ومناقشة الطلبة، وقيادتهم إلى اختيار فلسفة ومنهج يناسب توجهاته.
لن أتحدث عن كتاب يقيّد المعلم والطالب، ولا عن امتحان غبيّ من الكتاب. فالكتب وحفظها والامتحانات واجتيازها هي معيقات، وليست روافع للتعليم الحرّ، فأنتم تعرفون أنهم أخذوا الكتب من الطلبة خوفًا من رميها، بما يعني انقطاع علاقة الطالب بها، أما امتحان السمكة، والعصفور في تسلّق الشجرة، فالكل كشف هشاشتها!! لذلك، فإن خير ما يمكن اقتراحه هو البحث عن أنظمة تقويم غير الامتحانات!
وأخيرًا، التطوير التربوي يحتاج مطوّرين ذوي رؤًى، من غير الطبقة الميسورة حكوميّا، وإلّا سنبقى ندور ونشكو تراجع التعليم!