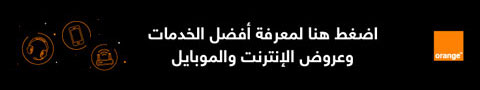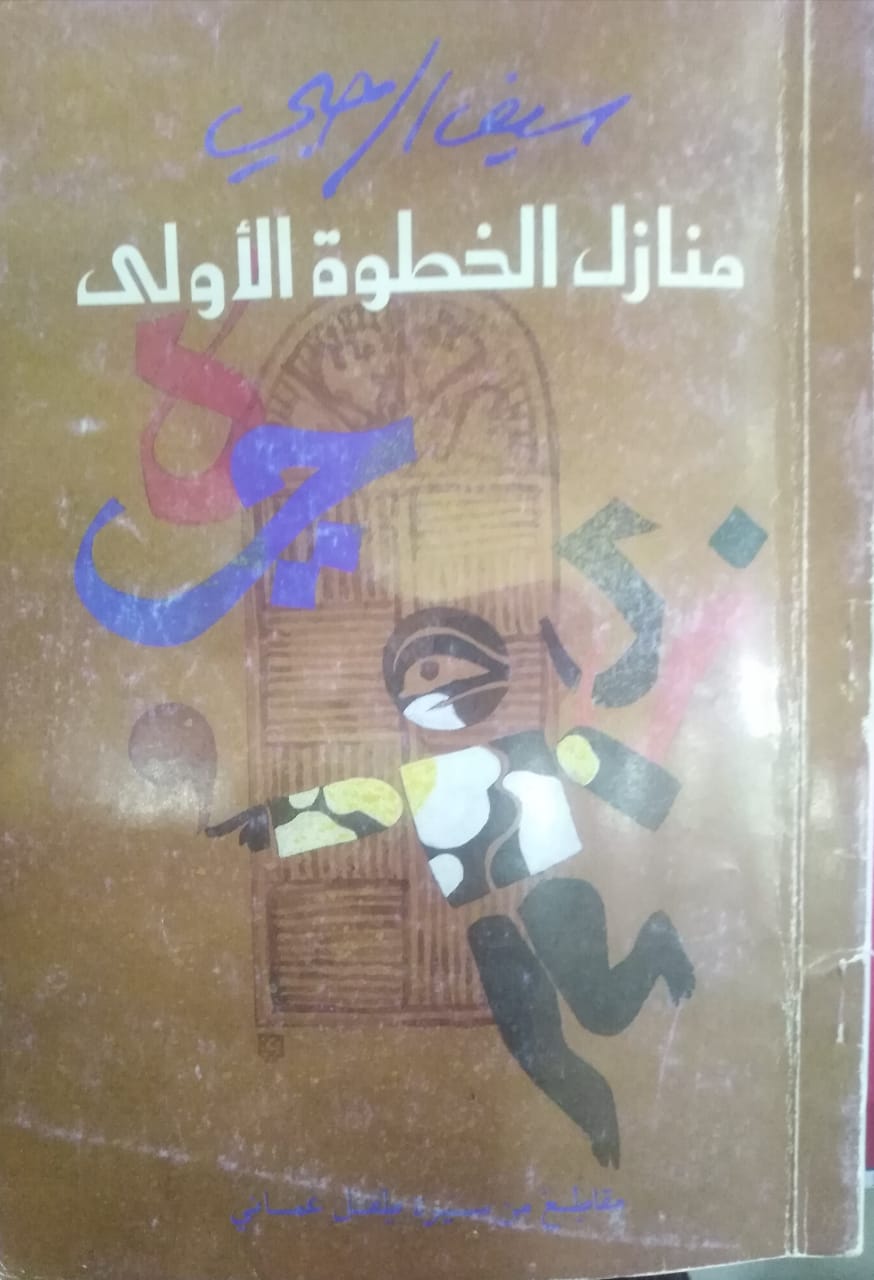منازل الخطوة الأولى، للأديب العُماني (سيف الرحبي)
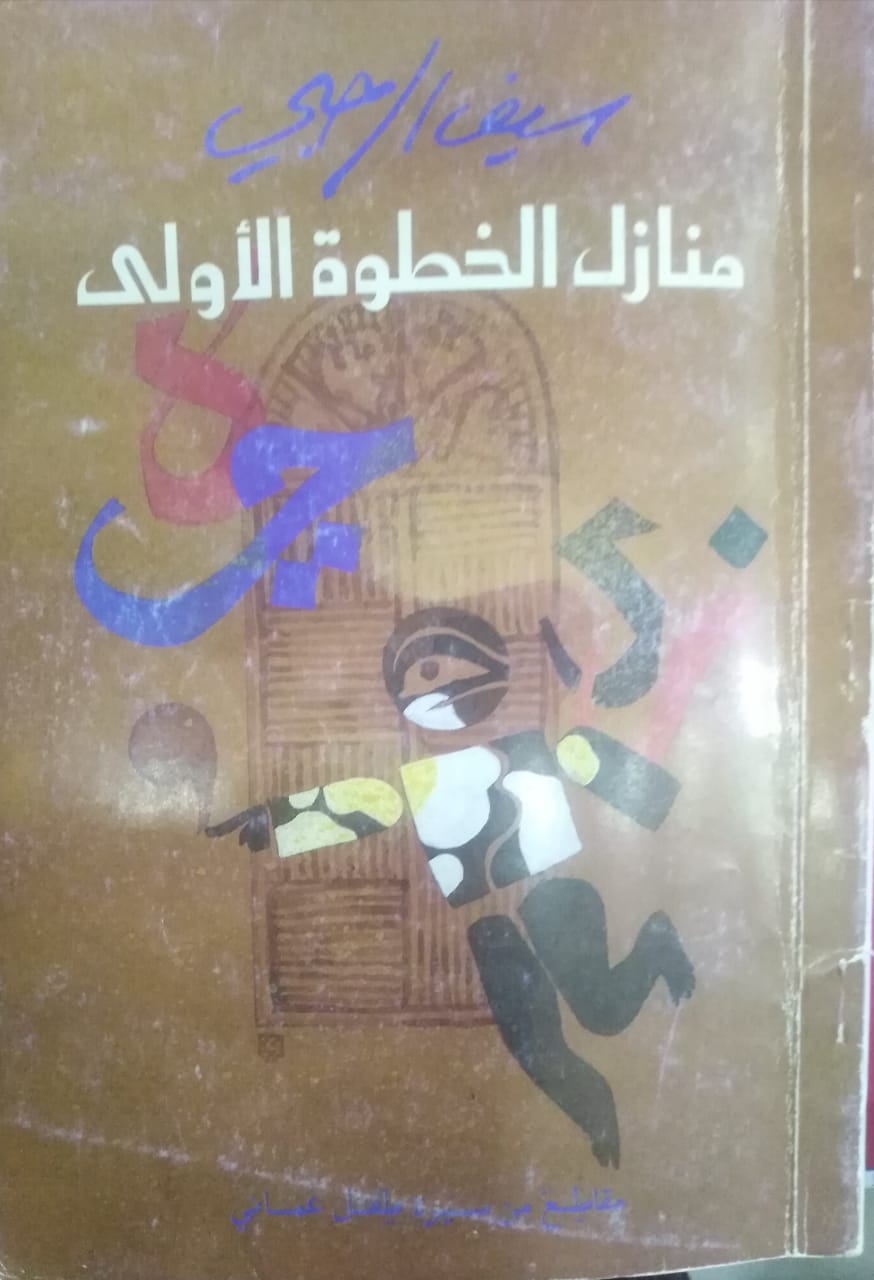
نبأ الأردن-عرض: سمير عبدالصمد- وُلد 1956 (سيف الرحبي) في قريةِ (سُرور) في ولايةِ (سمائل) الواقعةِ في المنطقةِ الداخليةِ من (سلطنة عُمان) وتلقَّى تعليمَه، بالكتاتيب ككلِّ أبناءِ جيلِهِ، ثم انتقل إلى (المدرسةِ السعيديةِ بمسقط) وبعدها سافر إلى العاصمةِ المصريةِ (القاهرة)، ليكملَ دراستَه الثانويةَ، ثم الجامعيةَ مُتخصصًا في دراسةِ الصحافةِ، وهناك أُتيحت له الفرصةُ للاطلاعِ على عيونِ الأدبِ العربي، وبخاصةٍ شعراءَ الحداثةِ، فانفتحت أمامه آفاقٌ واسعةٌ للقراءة والكتابةِ والنشرِ، والتأثُّرِ والتأثيرِ في مُجملِ الحالةِ الثقافيةِ النشطةِ، مُتفاعِلًا مع ألـمعِ رُوادِ الأدبِ المصريِّ.
في سنة 1979 انتقل إلى العاصمةِ السورية (دمشق) بعد أن بدأت تظهرُ ملامحُ شاعريته الـمرهفة، وتجلت موهبتُه الإبداعية، فأخذت إصداراتُه الشعريةُ تتوالى تِباعًا تاركةً بصمةً واضحةً في المشهد الثقافي بشكلٍ عامٍ، والشعريِّ بشكلٍ خاصٍ. وقد صدرت أعمالُه الشعريةُ والنثريةُ في: دمشق وبيروت والقاهرة، ومسقط، وباريس.
حصل (سيف الرحبي) على جائزة (السلطانُ قابوس التقديرية للثقافة والفنون) عام 2013، في مجالِ الشعرِ الفصيحِ، كما نال العديدَ من الأوسمةِ والجوائزِ التقديريةِ. تُرجمت أعمالُه إلى كثيرٍ من اللغات الحيةِ: كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية. وهو الآن يرأسُ تحريرَ (مجلة نزوى الثقافية الفصلية) التي تصدرُ في (مسقط).
من مؤلفاتِ (سيف الرحبي) النثرية والشعرية: ذاكرةُ الشتات، رأسُ المسافر، مِديةٌ واحدة لا تكفي لذبحِ عصفور، رجلٌ من الربع الخالي، رسائلُ الشوق والفراغ، نشيدُ الراعي. وأخيرًا صدرت أعمالُه الكاملة بعنوان (الأعمال الناجزة) عام 2022، في ثلاثةِ مُجلداتٍ ضمت نحو ألفِ صفحةٍ من القطعِ الكبيرِ، عن (دار العائدون للنشر والتوزيع) في العاصمةِ الأردنيةِ (عمَّان)، ضمت أعمالَه الشعريةَ والنثريةَ التي بلغت أكثرَ من ثلاثةَ عشرَ إصدارًا.
وسأحاول، هنا، إلقاءَ بعضِ الضَّوءِ على كتابِه (منازل الخطوة الأولى، مقاطع من سيرةِ طفلٍ عُمانيٍّ) الذي صدرت طبعتُه الأولى عام 1991. والذي يقول الكاتبُ في صفحتِه الأخيرةِ: (أن أحداثَ هذا الكتابِ تجري في مناخٍ زمنيٍ قبلَ عام السبعين، من القرنِ الذي نحن فيه، كما تُوحي بذلك علاماتُ المكانِ وملامحُه).
يُصدِّرُ الكاتبُ سيرتَه الذاتيةَ، على غيرِ عادةِ كُتَّابِ السيرةِ، بمقطعٍ شعريٍّ للشاعرِ الفلسطينيِّ (محمود درويش):
ما سِرُّ انبثاقِ هذا الماضي؟
أهو البحثُ عن طُفولةِ المكانِ،
أهو الشَّبَقُ لِـمُلاقاةِ مَكانِ الطفولةِ،
أم هو الاقترابُ من سؤالٍ سابقٍ:
ما البدايةُ؟ .. ما النهايةُ؟
يبدأُ (سيف الرحبي) سيرتَه من انشغال (سعد) بفكرةِ السفرِ التي تملأُ قلوبَ كثيرٍ من الشبابِ الراغبين بالهجرةِ بحثًا عن حياةٍ فُضلى، يقولُ: "كُنَّا نقفُ قبالةَ ذلك الشاطئ، مُحدِّقين في البحرِ الـمُترامي، بينَ الجبالِ التي تَحدُّه بِمُتوازيين، حيث تلتقي أطرافُها على حوافِ البندرِ، مُطلقين النظرَ على مداه في تلك الزُّرقةِ التي تغورُ من الجهةِ الأخرى في أشداقِ المحيطِ الهادي".
فكرةُ السفرِ، بحدِّ ذاتها، تظلُّ مُتوهجةً في نفوسِ الشبابِ الراغبين بالبحث عن تحقيقِ ذواتهم من خلالِ الانتقالِ إلى مكانٍ آخرَ، وبخاصةٍ من يعيشون في قريةٍ نائيةٍ، لا تتوفرُ فيها أبسطُ مُقوِّماتِ الحياةِ، وكان ذلك شأنَ كثيرٍ من البلداتِ العُمانية، قبلَ عهدِ النهضةِ.
يضيفُ: "في الليلِ تبدو المدينةُ، أو هذا المأوى البشريُّ، حين يخترقُ هدوءها الموحشَ عُواءُ الجهاتِ، وأصواتُ بناتِ آوى، وقد أنهكها حَدَسُ الفناءِ القادمِ، تبدو مثلَ حفرةِ زلزالٍ قديمٍ، أو مهبطٍ أدمنتُه النيازكُ، وقد نسيه العلماءُ والمؤرخون… قبالةَ الشاطئِ بمحاذاةِ حياةٍ توشكُ أن تكونَ ماضيًا، تَستجدي أيامًا قاحلةً لا تنفعُ مياهُ البحرِ في تلطيفِها، أو أيةُ أوهامٍ لمياهِ ينابيعَ تجودُ بها سماءُ الذاكرةِ… في هذه اللحظةِ التي تمرحُ فيها الأشباحُ بِحُرَّيةٍ في مرايا الجبالِ الـمُضاءةِ بالنورِ الشاحبِ للسفنِ والمناراتِ الشحيحةِ، في هذه اللحظةِ التي تبدو كقفزةٍ خارجَ الزمانِ والمكانِ، رغم أنها انغراسٌ فَظٌّ وطريٌّ في هذا المكانِ المائيِّ العائمِ في خيالِ الصِّبيةِ، فكَّر (سعد) أنه لا بدَّ أن يرحلَ إلى مكانٍ آخرَ، لا يعرفُ إلى أين، لكنَّه لا بدَّ أن يرحلَ"
فكرةُ الرحيلِ تُداعبِ خيالَ الطفلِ الـمُرهفِ الإحساسِ، الـمُتَّقدِ الشعورِ، لكن دون أن يحددَ أين ستكونُ وجهتُه التاليةُ … إنه الرحيلُ فقط، والبحثُ عن بصيصِ أملٍ، كَراعٍ مُنهَكٍ يبحثُ عن مَرعى خصبٍ لِقطيعِهِ الناحلِ من شِدَّةِ جوعِهِ.
يصف (سيف الرحبي) نُظمَ التعليمِ التقليديةَ التي كانت سائدةً في ذلك الزمنِ البعيدِ: "كانت قراءةُ تلك الأناشيدِ تَتَّخِذُ صيغةَ التَّهَدُّجِ والنغمِ العالي، متناوبةً بين العارفين وأشباهِهم، وأحيانًا تُتاحُ الفرصةُ لبعضِ الصِّبيةِ الذين بدأوا في معرفةِ القراءةِ والكتابةِ عبرَ كتاتيبِ القريةِ التي تُقامُ من سَعفِ النخيلِ أو في صروحِ المساجدِ.. ظلَّ (سعد) مُواظبًا على الذهابِ إلى مدرسةِ الكتاتيبِ حتى بعد أن تعلَّمَ القراءةَ والكتابةَ، ولم تَعُد مصدرَ مَعرفةٍ إضافيةٍ، لكن بقي هناك بالنسبةِ له جاذبيةُ الشِّجارِ مع تلاميذِ المدرسةِ، يحصلُ ذلك أحيانًا في المدرسةِ نفسِها، حين ينامُ المعلمُ ذو اللحيةِ الطويلةِ المجدولةِ، بينما يتلو سورةً أو يشرحُ متنًا ، نراه، وبهدوءٍ تدريجيٍّ يُغمضُ عينيه ويأخذُ في الشخيرِ، وفي اليومِ الذي لا يَسقطُ فيه المعلمُ في سُباتِه المألوفِ، ويبقى يقِظًا، تُبرَمُ مواعيدُ العراكِ خارجَ المدرسةِ في أماكنَ تتفقُ عليها الأطرافُ ذاتُ العلاقةِ في الـمُنازلةِ"
يصفُ (سيف الرحبي) قسوةَ الحياةِ في تلك الفترةِ الـمُبكرةِ من عمرِهِ والتي ساهمت في تشكيلِ شخصيتِه وثقافتِه، يقولُ: " في أحدِ الشتاءاتِ التي بدأت طلائعُهُ تُنذِرُ ببردٍ قادمٍ أكثرَ من الـمألوفِ، بَردُ (الصردِ) الذي يقطعُ الخُوصَ، كما كانوا يقولون، قررتِ العائلةُ بأمر الوالدِ الانتقالَ من البيتِ الـمُحاذي للوادي إلى البيتِ الذي بُنيَ حديثًا من طينٍ وماءٍ في منطقةٍ مُرتفعةٍ تقعُ في عُلوٍّ حَصينٍ على الجوائحِ والسيولِ… لم نكنْ نحن الصغارُ، ندركُ الفرقَ بين هذا البيتِ الواقعِ وسطَ ذلك النِّثارِ من البيوتِ الـمُتباعدةِ بصُرحانِها الشاحبةِ، وبين البيتِ الجديدِ الذي يقعُ ضِمنَ حيٍّ، وضِمنَ حارةٍ مليئةٍ بالصخبِ والنُّباحِ، لكنَّ الكبارَ أدركوا صُعوبةَ فراقِ المكانِ وأُلفَتِه التي ارتوت منها شرايينُ العائلةِ عبرَ الفصولِ والسنين، فضلًا عن قُربِه من المسجدِ الذي بناه الوالدُ، والفَلجِ الذي كانت تنامُ فيه الأنجمُ أزرادًا ودوائرَ، والذي هو جزءٌ من تكوينِ البيتِ ورُكنٌ من أركانِه"
يصف (سيف الرحبي) صعوبةَ الطقسِ، وقسوةِ العيشِ أمامِ الأنواءِ التي تَعصفُ بكلِّ شيءٍ، ولا تستطيعُ وسائلُ الحمايةِ البدائيةِ البسيطةِ أن تقيَهم من سطوتِها وعنفِها، يقولُ: "صباحٌ مُضطربُ المزاجِ منذُ بدايتِه مَصحوبًا بضجيجِ الحطابين الذين عادوا من غيرِ أن يستطيعوا مُواصلةَ جَلبِ الحطبِ، وكذلك (البياديرُ) لم يستطيعوا جنيَ الرُّطَبِ والثمارِ الأخرى، حيث عادوا ولـمَّا يصلوا بعدُ إلى عُذوقِ النخيلِ الفارعةِ التي تلعبُ بها الريحُ ذاتَ اليمينِ وذاتَ الشمالِ، مثلَ قواربَ صغيرةٍ تدفعُها عاصفةٌ… بدأ الناسُ يتجمعون في المجالسِ وعلى حوافِّ الوادي ، يشاهدون عبورَ العاصفةِ، ويتبادلون الأحاديثَ، وبعضُهم بدأ يتذمرُ حين شاهدَ أسرابَ القطا تَمرُّ عبرَ الوادي كدليلٍ يقودُ العاصفةَ إلى مقاصدِها، إن كان لها مقاصدُ… قضى سكانُ البلدةِ في الحديثِ والذكرياتِ عن العواصفِ والأمطارِ، وأثرُها على الإنسانِ والشجرِ والبيوتِ، بدأت البروقُ تُضيءُ فضاءَ القريةِ، خيولُ السماءِ الناريةِ بصهيلِها الذي لا ينقطعُ طوالَ الليلِ. كانت أولَ طلقةِ تحذيرٍ بقدومِ السيلِ الجارفِ بعدَ صلاةِ العشاءِ بالتحديدِ، وبعدَها توالت الطلقاتُ والزعيقُ، وعلا الهَرَجُ والـمَرجُ"
يصف (سيف الرحبي) مسجدَ القريةِ القائمَ بين الصخورِ الصلبةِ ببساطةِ بنائه في مكانٍ صعبِ الـمُرتقى، لا يمكنُ أن تصلَ إليه إلَّا عبرَ طُرقٍ مُلتويةٍ، لكنه كان رغمَ ذلك مَحَجًا للأفواجِ الزائرةِ بين حينٍ وآخرَ، والتي كانت تؤنسُ وحدتَه، يأتون إليه حاملين نُذورَهم وقرابينَهم،يلتمسون فيه البركةَ ويرجون صلاحَ الأحوالِ وتحقيقَ الأماني. كان المسجدُ أيضًا مكانًا اختاره أعيانُ القريةِ ليكونَ مَدرسةً تُعلِّمُ مبادئَ الفقهِ والنحوِ والصرفِ، يقومُ بالتدريسِ فيه (شابٌ لم يتجاوزِ العشرينيات من العمرِ؛ لكنه حافظٌ للقرآنِ الكريمِ، نابغةٌ في علومِ الدينِ، زاهدٌ وقورٌ، عُرِفَ عنه التقوى وسعةُ الأفقِ، كان كلُّ همِّه أن يكسبَ قلوبَ طلابِه ومُحبيه؛ لكي يغرسَ فسيلةَ المعرفةِ في أذهانِهم)
يقول (سيف الرحبي): مسجدُ (الفجِّ) الواقعُ خلفَ الوادي في الجهةِ القريبةِ من القريةِ تحتَ سطوةِ الظلِّ الهائلِ للجبالِ وأشجارِ الغافِ المأهولةِ دائمًا بالريحِ، حتى حين لم يكن هناك هبوبٌ… مسجدُ (الفجِّ) الواقفُ كجُرحٍ مُقدَّسٍ في هذا الأبدِ الجاثمِ على مدخلِ تلك الفِجاجِ الصخريةِ العميقةِ بين الجبالِ مُشكِّلةً طريقًا مُلتويةً، يمتدُّ حتى (سمائل) يراه الداخلُ إلى القريةِ من جانبِها العُلويِّ أو السُّفليِّ، وحيدًا ليس بجوارِه أيُّ منزلٍ أومأوى، عدا الأعشاشَ والريشَ… كانت تأتي إليه الأفواجُ الزائرةُ لِـما يتمتَّعُ به من سُمعةٍ وحكاياتٍ تُروى أبًا عن جَدٍّ، عن مناقبِ كراماتِهِ وخِصالِه الضاربةِ في القِدمِ، مما يجعلُ الزائرَ وقاصدَ المكانِ مغمورًا بهذا الفيضِ الربانيِّ للبركةِ، وربما سموُّ عُزلتِه وموقعُه الفريدُ ساعَدا على خَلقِ هذه الهالةِ الروحيةِ حولَه… بالإضافةِ إلى هذا، كان المسجدُ مَحِجَةَ النُّذورِ والقرابين، يأتيه الناسُ مُتجشمين الطُّرقَ الوعِرةَ على الحميرِ والجمالِ من مناطقَ مُختلفةٍ، مدفوعين بإيمانٍ حاسمٍ لا تشوبُه شائبةٌ بفاعليتِه الروحيةِ في تحقيقِ أمانيهم حولَ الصحةِ والمرضِ والأحلامِ الأخرى.
يصفُ (سيف الرحبي) جانبًا من الـمُعاناةِ التي كان يعيشُها أهلُ قريتِه، حيثُ لا توجدُ أيةُ مرافقَ صحيةٍ، ولا حتى خدماتٍ طبيةٍ أوليةٍ، بل كلُّ ما هو موجدٌ علاجاتٌ بدائيةٌ توارثوها، حيث لم يسمع (سعد) بكلمةِ (مستشفى) حين مرضت عمتُه، بل سمعَ صياحَ الدجاجةِ السوداءِ وهي تُذبَحُ طلبًا للعلاجِ. أما حين رفسَه الحمارُ الأسودُ ،الذي ربَّاه وأطعَمَه القتَّ المسروقَ، رَفسَتَهُ القويةَ السَّكرى، وسقط مُصابًا بفكِّه الأسفلِ، مما اضطرَ أهلَه لاحقًا إلى حملِه إلى المستشفى، وتلك هي المرةُ الأولى التي يذهبُ فيها (سعدٌ) إلى شيءٍ اسمُه مستشفى.
يضيفُ (سيف الرحبي): "بالطبعِ لم يكن في القريةِ مستشفى أو عيادةٌ طبيةٌ، ولا في بقيةِ القرى والمناطقِ. كان الناسُ يتداوون بالأعشابِ البريةِ، والوصفاتِ الـمُتوارَثةِ، وكذلك التعاويذِ والـمَحوِ الذي يُطبَعُ على آنيةٍ زُجاجيةٍ بحروفٍ تُشبهُ الأبجديةَ الصينيةَ والتي يلعَقُها المريضُ بلسانِه طلبًا للشفاء، حتى أن بعضَ القادمين من (خارجِ البلادِ) حيثُ كانوا يعملون بها في مِهَنٍ بدنيةٍ مُختلفةٍ، يحاولون صدمةَ سُكانِ القريةِ بالكلامِ عن مُعجزاتِ الطبِّ الحديثِ التي سمعوا عنها هناك، لكنَّ البعضَ يُسارعُ بالردِّ عليهم مُؤكدًا أنَّ الأمرَ بيدِ اللهِ، وأن ذلك الطبَّ المزعومَ لن يكونَ أفضلَ من العاداتِ التي توارثَ النسلُ نجاعتَها الأكيدةَ، وحين طرح أحدُ القادمين بأن بعضَ أعضاءِ المريضِ التالفةِ يُمكنُ أن تُستبدلَ بأخرى سارعَ الجميعُ بصوتٍ واحدٍ إلى الاستغفارِ والردِّ الصارمِ على الأقاويلِ التي يروجُّها الكَفَرةُ، وأصحابُ الإيمانِ الضعيفِ. في البلدةِ مات أطفالٌ كثيرون بسببِ الحصبةِ، رغمَ البولِ الذي يسقونهم إياهُ بكمياتٍ مُتعاقبةٍ، بولُ الصباحِ الساخنُ، وماتوا بأمراضٍ أخرى لم تكن معروفةً"
ينقلُ (سيف الرحبي) في سيرتِه صورًا متعددةً لـمَشاهدِ دخولِ السيارةِ إلى قريتِه، حيث يتزاحمُ حولَها الكبارُ والصغارُ، مُتعجبين من قدرتِها على الحركةِ رغمَ ضخامتِها، وحين تتعطلُ وتتوقفُ عن المسيرِ، يَتندَّرون قائلين: (الحمارُ الأعرجُ أفضلُ من السيارةِ؛ لأنَّ الحمارَ يوصلُكَ، أما السيارةُ فغيرُ مضمونةٍ)
يقول: "لم يكن أهلُ القريةِ قد اعتادوا على السياراتِ بعدُ، كانت السياراتُ التي تطوفُ البلدةَ في الذهابِ والإيابِ محدودةً لا تتجاوزُ نصفَ أصابعِ اليدِ، كانت تُشحَنُ بالبضائعِ من قَعرِ أرضيَّتِـها الحديديةِ، حتى سقفِ الأعمدةِ الـمُتشابكةِ في الفضاءِ، والركابُ يَستوون كالـمُعلقين في الهواءِ فوقَ حُمولةِ البضائعِ، مُتمسكين بأقصى ما يملكون من قُوةٍ بما تَبقَّى من أطرافِ الأعمدةِ. وحين تعبرُ السيارةُ المضائقَ والطرقَ الوَعرةَ الكثيرةَ، كأن تمشي على حافةِ هاويةٍ، أو تصعدُ مُرتفعاتٍ جبليةً أو مُنزلقاتِ وادٍ صخريٍ يكتمُ الركابُ أنفاسَهم، ويستحلبون ريقًا جافًّا لـمُواجهةِ الخوفِ… في تلك الفترةِ، لا يكادُ أهالي القريةِ يسمعون صوتَ سيارةٍ من البعيدِ، سواءً كان ذلك نهارًا، حيث تحيطُ بها تياراتُ الغبارِ، أو ليلًا حيث تُشِعُّ بأضوائها الـمُضطربةِ من خلفِ الآكامِ والتلالِ، إلَّا ويتسابقون نحو الطريقِ بانتظارِ قادمٍ تُلقيه في طريقِها، أو لأجلِ راكبٍ نحو بلدةٍ أخرى أو للفُرجةِ، يَتحلَّقون حولَها، ويتبادلون الكلامَ مع السائقِ والركابِ مُلِحِّين عليهم بالنزولِ للقهوةِ أو الطعامِ…أما الصِّبيةُ فيظلون واقفين مُترصِّدين لحظةَ ذهابِ الكبارِ، وما أن تتحركَ إلَّا ويركضون وراءها مُتعلقين بأسياخِ المؤخرةِ، لا يثنيهم عن ذلك صياحُ السائقِ والركابِ، ولا يتركونها حتى تختفيَ من حدودِ القريةِ، وقد امتلأت أرجلُهم وأياديهم بالكدماتِ والرضوضِ… كانت بعضُ هياكلِ السياراتِ الـمُتدحرجةِ من الجبالِ، نراها مُختلطةً بهياكلِ الجِمالِ والدوابِ الأخرى مُشكِّلةً جيفةَ حديدٍ وعظامٍ، ويمكنُك أن ترى خليطَ حيواناتِ ما قبلَ التاريخِ، مَعجونًا بنفاياتِ حضارةِ الحديدِ.
ينقلُ (سيف الرحبي) في سيرتِه صورًا متعددةً لـمَشاهدِ دخولِ السيارةِ إلى قريتِه، حيث يتزاحمُ حولَها الكبارُ والصغارُ، مُتعجبين من قدرتِها على الحركةِ رغمَ ضخامتِها، وحين تتعطلُ وتتوقفُ عن المسيرِ، يَتندَّرون قائلين: (الحمارُ الأعرجُ أفضلُ من السيارةِ؛ لأنَّ الحمارَ يوصلُكَ، أما السيارةُ فغيرُ مضمونةٍ)
يقول: "لم يكن أهلُ القريةِ قد اعتادوا على السياراتِ بعدُ، كانت السياراتُ التي تطوفُ البلدةَ في الذهابِ والإيابِ محدودةً لا تتجاوزُ نصفَ أصابعِ اليدِ، كانت تُشحَنُ بالبضائعِ من قَعرِ أرضيَّتِـها الحديديةِ، حتى سقفِ الأعمدةِ الـمُتشابكةِ في الفضاءِ، والركابُ يَستوون كالـمُعلقين في الهواءِ فوقَ حُمولةِ البضائعِ، مُتمسكين بأقصى ما يملكون من قُوةٍ بما تَبقَّى من أطرافِ الأعمدةِ. وحين تعبرُ السيارةُ المضائقَ والطرقَ الوَعرةَ الكثيرةَ، كأن تمشي على حافةِ هاويةٍ، أو تصعدُ مُرتفعاتٍ جبليةً أو مُنزلقاتِ وادٍ صخريٍ يكتمُ الركابُ أنفاسَهم، ويستحلبون ريقًا جافًّا لـمُواجهةِ الخوفِ… في تلك الفترةِ، لا يكادُ أهالي القريةِ يسمعون صوتَ سيارةٍ من البعيدِ، سواءً كان ذلك نهارًا، حيث تحيطُ بها تياراتُ الغبارِ، أو ليلًا حيث تُشِعُّ بأضوائها الـمُضطربةِ من خلفِ الآكامِ والتلالِ، إلَّا ويتسابقون نحو الطريقِ بانتظارِ قادمٍ تُلقيه في طريقِها، أو لأجلِ راكبٍ نحو بلدةٍ أخرى أو للفُرجةِ، يَتحلَّقون حولَها، ويتبادلون الكلامَ مع السائقِ والركابِ مُلِحِّين عليهم بالنزولِ للقهوةِ أو الطعامِ…أما الصِّبيةُ فيظلون واقفين مُترصِّدين لحظةَ ذهابِ الكبارِ، وما أن تتحركَ إلَّا ويركضون وراءها مُتعلقين بأسياخِ المؤخرةِ، لا يثنيهم عن ذلك صياحُ السائقِ والركابِ، ولا يتركونها حتى تختفيَ من حدودِ القريةِ، وقد امتلأت أرجلُهم وأياديهم بالكدماتِ والرضوضِ… كانت بعضُ هياكلِ السياراتِ الـمُتدحرجةِ من الجبالِ، نراها مُختلطةً بهياكلِ الجِمالِ والدوابِ الأخرى مُشكِّلةً جيفةَ حديدٍ وعظامٍ، ويمكنُك أن ترى خليطَ حيواناتِ ما قبلَ التاريخِ، مَعجونًا بنفاياتِ حضارةِ الحديدِ.
خِتامًا:
إن القراءةَ الـمُتأنيةَ لسيرةِ (سيف الرحبي) تدعونا لنقفَ أمامَ مجموعةٍ من الملامحِ التي لا يمكنُ تجاوزُها، والتي يتفردُ بها في كتابةِ سيرتِه، تجعلُه مُتميزًا في عرضِه وأسلوبِه ومجموعةِ الأفكارِ التي يطرحُها:
تُعدُّ هذه السيرةُ تسجيلًا واقعيًا لفترةٍ زمنيةٍ من حياةِ الكاتبِ، تتقاطعُ مع حياةِ مُعظمِ أبناءِ جيلِه، الذين افتقدوا كثيرًا مما تتميزُ به أبسطُ مُتطلباتِ الحياةِ الحضاريةِ في النصفِ الثاني من القرنِ العشرين، والتي ظلَّ مُعظمُ العُمانيين مَحرومين منها حتى بدايةِ سبعينياتِ القرنِ الماضي، ومن أهمِّها، ثنائيةُ الصحةِ والتعليمِ.يتكلمُ الكاتبُ بصيغةِ ضميرِ الغائبِ، مُختارًا لنفسه اسمَ (سعد) وكأن الاسمَ يتماهى مع اسمِ قريتِه (سرور) وهما اسمان مُغرقان في السعادةِ والتفاؤل، يقول: "كانت تلك المرةَ الأولى التي تحومُ فيها فكرةُ السفرِ بمعناه البعيدِ، في مُخيلةِ (سعد)" وهذا يوحي بنظرتِه الإيجابيةِ للمستقبلِ. وهكذا كانت حياةُ (الرحبي) مُوغلةً في الجمالِ، يبحثُ عنه في القريةِ الفقيرةِ وأهلِها البسطاءِ، وفي ضوضاءِ المدينةِ وصخبِها، في زحمةِ العواصمِ والمدنِ العربيةِ والأجنبيةِ، وفي صحراءِ الرُّبع الخالي وأرضِه اليباب، وجبالِه العصيةِ، وفي البحرِ الهادئ والمضطربِ، وفي السفرِ والسُّكونِ، في كل هذه الـمُتناقضاتِ كان (الرحبي) مُتصالِحًا مع ذاتِه، مُتكيِّفًا بكلِّ هدوئه مع اختلافِ الزمانِ والمكانِ.يشيرُ (الرحبي) إلى أنه كان من أسرةٍ تحرصُ على اقتناءِ الكتبِ، وقراءة مخطوطاتٌ في مجالاتٍ مُتنوعةٍ، حسب ما توفِّره ظروفُ قريته ومجتمعِه، وهذا هيَّأ له جوًّا من الثقافة، حتى ولوكان بسيطًا، لكنه كان كافيًا، بلا شك، لإثارةِ شَغَفِه في حبِّ الاطلاعِ، وتزويدِه بحصيلةٍ معرفِيةٍ اختزنتها ذاكرتُه، وشكّلت شخصيتَه الثقافيةَ التي أبدعت فيما بعدُ هذه الحصيلةَ المتنوعةَ من الإصداراتِ الأدبيةِ المتنوعةِ، ، يقول: "كان والدُ (سعد) يمتلكُ مكتبةً وضع كتبَها في رفوفٍ مُتراصةٍ في المجلسِ الداخليِّ للبيتِ، ضمَّ أسفارًا مُختلفةً، وهي مخطوطاتٌ تتوزَّع بين الفقهِ وأصولِ الدِّينِ والتاريخِ والشعرِ، كان (والدُ سعد) شديدَ الاعتدادِ والعنايةِ بها، حتى حين كان يعودُ من سفرِ طويلٍ، ويجدُ العنكبوتَ قد نسجَ بيوتَه الشبكيةَ على الرفوفِ والجدرانِ يصرخُ في وجهِ الجميعِ، ويتهمُهم بالرداءةِ والجهلِ، ولا يهدِّئُ جيشانَ غضبِه إلا الإسراعُ في كنسِها وتنظيفِها"ينشغلُ (الرحبي) في التفاصيلِ الصغيرةِ، وتكادُ عينُه تلتقطُ كلَّ مما يدورُ حولَه. وينقلُها للقارئ؛ لتجعلَه يكادُ يراها بواقعيةٍ، دون تمويهٍ أوتشويهٍ، أو تلاعبٍ ببريقِ الكلماتِ. مثل قولِه: "لكن يُمكنُ للرائي على مَقربةِ من أولئك الصِّبيةِ الـمُندفعين حُفاةً عبر سفحِ الجبلِ في يومٍ شتائيٍّ، خلّفَ وراءه غبارَ مواسمِ الحصادِ والأمطارِ التي كانت تنشرُ رُطبَها وبُسرَها في ذلك السفحِ الغافي مثل سديمٍ ينهبُه العراءُ". أو حين نقرأُ: … وفي أيامِ الجُمَعِ كنا نتخلَّفُ عن الذاهبين بشكلٍ مُبكِّرٍ للمساجدِ؛ لنذهبَ إلى البحرِ، وحين يكونُ في حالةٍ لا يُمكن السباحةُ معها، نضطجعُ على الشاطئ، ونبدأُ في جمعِ الأحجارِ البيضاءِ الشفافةِ التي نكتبُ عليها ما نحسبُه شعرًا أو عباراتٍ دينيةً صيغت بشكلٍ شعريٍ مُستحضرين أيامَ القريةِ حين كُنَّا نكتبُ على كتفٍ خُلِعَ من جَملٍ مَيِّتٍ، كتفٍ أبيضَ ناصعٍ، كأنما هو مصقولٌ بأدواتِ صفَّارين. وفيما بعد حين تطورت أواني المعرفةِ، صرنا نكتبُ في سبورةٍ صغيرة". إنك لا تستطيعُ أن تتوقفَ عن الاقتباساتِ من نصوصِ الكاتبِ، فكلُّها تُعبِّرُ عن عقليةٍ واضحةٍ، ولُغةٍ راقيةٍ، وهدفٍ سامٍ، مُحترِمًا خُصوصيةَ المكانِ، وواعيًا لخصوصيةِ الزمانِ، وخصوصيةِ الثقافةِ العُمانية التي تدورُ فيها أحداثُ سنيِّ حياتِه الأولى، والتي ساهمت في تَشكُّلِ ثقافتِه وتطوُّرِ شخصيتِه، وارتقاءِ ذائقتِه الأدبيةِ ومهارتِه اللغويةِ الـمُستلَّةِ من بيئته البسيطةِ التي نلاحظُ توظيفَها في أعمالِه التالية، فهو رغم تَرحالِه الـمُتواصلِ، وتَنقُّلِه في أصقاعِ الدنيا، وعَيشِه في أجواءٍ مُتباينهٍ، وتَعامُلِه مع أعراقٍ مختلفةٍ من الناسِ، ما زال يحملُ رائحةَ القريةِ في وِجدانِه، ومازال صدى صراخِ أطفالِها ودُعاءِ شيوخِها، وترانيمِ أغانيها، وزغاريدِ نسائها، وحفيفِ أشجارِها وتغريدِ طيورِها، وضجيجِ مخلوقاتِها، وهديرِ أمواجِ بحرِها، ما زال كلُّ ذلك يموجُ في ذاكرتِه، ويسكنُ في حنايا نفسِه الحساسةِ، وعينِه الباصرةِ التي تلتقطُ كلَّ ما حولها بوعيٍّ؛ لتخرجَ نصوصُه إلينا في فضاءات ِالنشرِ الـمُتسعةِ، مالئةً النفوسَ بجمالِها وألقِها، تقرأُ وكأنك تُشاهدُ الأمكنةَ التي جرت فيها الأحداثُ.لا يستطيعُ القارئُ أن يفصلَ بين (الرحبي الكاتب والرحبي الشاعر)، فحينما تتوغلُ في نصوصِه الشعريةِ تحسُّ كأنك تقرأ نثرًا، وحينما تقرأ نثرَه تشعرُ وكأنك تقرأُ شعرًا. في (منازل الخطوةِ الأولى) تتفاجأُ بروعةِ لغةِ الشعرِ، ورُقيِّ العباراتٍ، وجودةِ الاستعاراتِ ودقةِ التشبيهاتِ والكناياتِ دون تكلِّفٍ أوتصنُّعٍ، مثلًا: "تتقاطعُ الأيامُ، والزمنُ يتكوَّرُ مثلُ بطنِ الحواملِ، وهن يذهَبْن لِجَلبِ الـمياهِ من وَقَبِ الأفلاجِ ومفاصلِها عبرَ الطريقِ الـمُترِبةِ، أو يسيلُ سيلانًا دَبِقًا مع هَبَّةِ الريحِ الشماليةِ على سُمَّارِ المجالسِ، وهم يقرأون كُتَبَ الدينِ وقَصصِ البطولاتِ، وإعجابًا لأولئك الغابرين الذين مازالوا غذاءً للقلبِ ووقودًا للذاكرةِ، مَرجِعَ الحكمةِ وعِقالَ العواطفِ من زوغانِها على أيدي الأفكارِ الجديدةِ التي تَهُبُّ رياحُها على أهلِ القريةِ". أو حينما يقول: "وما كادت أضواءُ الفجرِ الأولى تنشقُّ عن عتمتِها اللاهيةِ إلَّا والراحلون مُتحفزون للسيرِ تُودعُهم عينا أمٍ لم تعرف طعمَ الفراقِ بعدُ، وبشكلِهِ الجَديِّ المريرِ… ظلوا سائرين عبرَ الشعابِ والوديانِ، عبرَ الطرقِ الصخريةِ التي حفرتها الإرادةُ الصلبةُ لأولئك الرعيانِ والعابرين بين الجبالِ والسُّهوبِ والانهياراتِ التي تتوالدُ عبرَ أشكالِ من الخُرافةِ الأرضيةِ، خُرافةِ المكانِ بافتراساتِه الـمُتبادلةِ لقاطنين يعيشون حياةَ الظَّعنِ الأولى".أو حينما يقولُ: "في الصباحاتِ الكثيرةِ التي يتكشَّفُ عنها ليلُ القريةِ، هناك صباحاتٌ تبقى مثلَ نَبعٍ خفيٍّ في الذاكرةِ، صَباحاتٌ لا يمكنُ القبضُ عليها أو اعتقالُها خوفًا من صيروةِ النسيانِ الحتميِّ عبرَ إشراكِ لغةٍ تُعلنُ تَمَنُّعُها باستمرارٍ"يلاحظُ القارئُ حِرصَ (الرحبي) على استخدامِ ألفاظٍ أو جُمَلٍ أو تراكيبَ مُستلَّةً من خصوصيةِ البيئةِ العُمانيةِ، مثل: "مشى تلاميذُ المدرسةِ صفًّا مُستقيمًا يتقدمُه المعلمُ وقارئُ النشيدِ المعروفِ باسمِ (التويمينة) إلى بيتِ العائلةِ"، "وفي ظلالِ مساءاتِه الواسعةِ تُقامُ (العزوات) ويتبارى فيها الباعةُ والمشترون للحلوى المتنوعةِ". وسواها من الكلماتِ أو التراكيبِ التي تتناثرُ في ثنايا نصِّه، مُوغلةً في المكانِ الذي تولَّدت فيه، وهنا تظهرُ أهميةُ أن يكونَ النصُّ قريبًا من بيئتِه وطبيعةِ مَن يَعيشُون فيها، وأهميةُ مفهومِ أنَّ العالميةَ في الأدبِ لا تقتضي أن يناقِشَ الكاتبُ فكرةً عالميةً يتفق عليها الكثيرون في مساحاتِ هذا الكونِ الواسعِ. إن البساطةَ في البيئةِ والنصِّ والصورةِ والدقةِ في العبارةِ من عناوينِ روعةِ (الرحبي) الكثيرةِ.تصلح هذه السيرة الذاتية أن تكون مرجعًا مُهمًّا لدارسي علم الإنسان والدراسات الاجتماعية.
يتناول (الرحبي) الحياةَ الفطرية والبيئية والعلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع ونظرتهم للحياة كلٌّ من ناحيته الخاصة، فهو يطلُّ على مختلف مستويات الحياة بكل تناقضاتها وتفاصيلها ينقلُها بواقعية، بكل إيجابياتها وسلبياتها، دون تزويق وتلوين أو تضليل، فالدقة في الوصف الواقعي، للبيئة بكل مفرداتها من إنسان وحيوان ونباتات ومعالم طبيعية، تجعل القارئ ينحاز إلى معايير الجمال والإبداع والإمتاع، بل ويكاد يتخيلُ هذه المفرداتِ المتناثرةَ وكأنه يراها، هذا ما يجعلني أصف النصَّ بالوثيقة المكتوبة، لا بالسيرة السردية التي تبحث عن مُغريات الإثارة والتشويق على حساب الواقعِ والحقيقة.